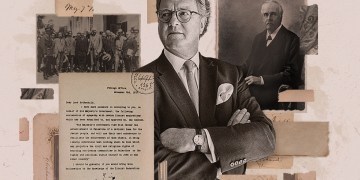ما الذي يعنيه أن نكون مجتمعاً تنويرياً في سوريا؟ ليس في السياق الثقافي المجرّد، وإنما في بنيتنا السياسية وصيغ التمثيل، وشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع.
خلال مراحل إعادة التأسيس السياسي، يتحوّل التنوير من إنتاجٍ للمعرفة إلى أداة لتفكيك شرعية السلطة، والسؤال عن أُسس تمثيلها ومصادر مشروعيتها. لا يقع التنوير في مواجهة الدين أو الهويات، بل في مواجهة احتكار المعنى وتَمركُز الشرعية السياسية باسم المقدّس. يتمثل دوره في تفكيك احتكار الشرعية وإعادة السيادة إلى المجتمع بتعبيراته المتعددة. بهذا المعنى، يتجاوز التنوير حدود التثقيف النخبوي أو الوعي المعزول، ليُصبح إرادة سياسية تعيد بناء الدولة على أُسس تعاقدية. إنه فعلٌ يُزعزع الثوابت الموروثة حول الحاكم والطائفة والمقدّس، ويُعيد صياغتها ضمن عقد سيادي جديد، تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجتمع، باعتباره مصدر السيادة الوحيد.
لكن هذه الرؤية التأسيسية كانت عرضة لنقدٍ عميق منذ أواخر القرن العشرين، خاصة في نسختها الأوروبية. فقد رأى ميشال فوكو أن التنوير يؤدي وظيفة معرفية تُعيد إنتاج السلطة من خلال الخطاب والمؤسسات. بالمقابل، قدّم يورغن هابرماس تصوراً مغايراً، داعياً إلى استكمال مشروع التنوير من خلال بناء عقل تواصلي عمومي، يقوم على الحوار والمشاركة ويُدار ضمن مؤسسات تتيح تعدد الآراء وتكافؤ التعبير.
نتيجة لهذه المراجعات، يُفهَم التنوير كمشروع سياسي يهدف إلى استعادة الفضاء العمومي من هيمنة الجماعة أو الفرد، وتأسيس دولة حيادية تقوم على التعدد والتمثيل، وتمنع احتكار المعنى من أي مرجعية مغلقة.
لم يكن التنوير في سوريا يوماً مشكلة ثقافية فحسب، بل ظلّ على تماسٍ مباشر مع انكسار المعنى السياسي للدولة نفسها. فحين تُختزَل الدولة في تمثيل سلطوي ضيق وتُفرَغ من مضمونها التعاقدي والمؤسسي، يفقد التنوير شروطه التأسيسية ويتحوّل إلى فعل مُجتزأ، محدود الأثر.
والتنوير المقصود هنا لا يُختزَل في المعرفة أو النقد الثقافي، لكن يجب أن نفهمه كفعل سياسي يُعيد تعريف الدولة بوصفها عقداً مدنياً ومجالاً عاماً للسيادة المشتركة. بهذا المعنى، يقترب التنوير الوطني كما نقصده هنا، من ما أشار إليه ميغيل أبينسور بوصفه «التنوير السياسي»: فعلٌ يقوّض بنية السلطة عبر مُساءَلتها، ويستعيد الدولة كمجال للصراع المشروع وليس الخضوع المألوف، وهو ما يتقاطع أيضاً مع ملاحظة عبد الله العروي، الذي رأى أنّ فشل الحداثة السياسية في السياق العربي لم يكن بسبب غياب مفاهيمها، بل نتيجة غياب شروطها التاريخية، وعلى رأسها غياب نشوء الدولة على أساس التعاقد السياسي بين المواطنين، في مقابل حضور قوي لمفهوم الدولة كإرث رمزي، تُختزَل فيه السلطة في رموز الولاء والانتماء لا في قواعد المشاركة والسيادة العامة.
من طغيان الدولة الفرد إلى طغيان الجماعة؟
اليوم، بعد سقوط نظام الأسد الديكتاتوري الذي أطاح بفكرة الدولة لصالح سلطة الفرد، تتصدّرُ المشهدَ سلطة انتقالية تُجسّد نموذجاً سلطوياً ذا مرجعية سلفية-جهادية، قائم في جوهره على تصوّرات دينية ما قبل-دولتية. في هذا السياق يستحيل تصور مشروع تنويري ينبثق من داخل سلطة تنكر مبادئ الدولة الحديثة، وفي مقدّمتها الطابع المدني، والتعددية السياسية، والانضباط لقواعد السيادة الشعبية. فالتنوير بمعناه السياسي، يقتضي إعادة تصور الدولة كإطار جامع لإرادة مدنية مشتركة، يتجاوز منطق الغَلَبة والتمثيل الأحادي، وينهض على قاعدة المشاركة والسيادة الشعبية.
«التنوير الوطني» هنا لا يُقصَد به مجرد تحديث ثقافي أو انفتاح معرفي على العالم، ولا يستدعي بالضرورة الإرث الأوروبي للتنوير بصيغته الكلاسيكية التي نشأت في مواجهة الكنيسة والمَلَكية. ما نقصده هو فعلٌ سياسيٌ-فكريٌ معاً، يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين المجتمع والدولة في سوريا على أُسس عقلانية وتعاقدية وتشاركية، بما يُعيد السيادة إلى الناس، ويُفرِغُ السلطة من طابعها المطلق أو المقدّس.
التنوير الوطني، بهذا المعنى، لا يقتصر على كونه مشروعاً نخبوياً ولا حالة ثقافية محضة، وإنما يتجاوز ذلك ليكون في موقع مقاومة رمزية ضد تَديين السلطة وشيطنة مفهوم الدولة وتأبيد الوصاية. هو محاولة لاستعادة الدولة كفكرة عامة، وليس كإقطاع إيديولوجي فقط، وهو ما يقتضي تفكيك البنى الرمزية التي تُحوِّلُ السلطة إلى مصير محتوم، أو تحصر مفهوم الوطنية السورية في هوية السلطة أو الجماعة أو الطائفة.
يأتي التنوير الوطني في الحالة السورية كضرورة مزدوجة؛ فهو في الآن ذاته أداة لتفكيك إرث سلطوي طويل، ووسيلة لمُساءلة البنية الجديدة التي تحاول احتكار الحق والحقيقة باسم الشرع أو الغَلَبة أو الانتماء العقائدي.
كما لا يمكن الحديث عن مشروع تنوير وطني سوريّ في ظل غياب الشرط العلماني الأدنى، الذي يضمن حياد الدولة تجاه الأديان والعقائد. فالعلمانية في جوهرها تقوم على تحييد المقدّس عن الشأن العام، بما يمنع احتكار المجال السياسي باسم الاعتقاد، ويكفل المساواة في الحقوق والتمثيل بين المختلفين.
نواة السلطة الانتقالية بتأسيسها وطابعها الإسلامي تُقصي هذا الشرط جذرياً؛ إذ لا يبدو أنها تنطلق من مفهوم «الدولة» بوصفها عقداً سياسياً عاماً، وإنما من تصوّر ديني «أُمَّتي» يرى الدولة أداة لحراسة العقيدة وتطبيق الشريعة. وفي هذا السياق، لا بد أن تغدو العلمانية شرطاً للبقاء السياسي للمجتمع المتعدد، لأن غيابها يبرّر الإقصاء والتكفير ومصادرة التعدد لصالح «الفرقة الناجية» أو «المنهج الحق».
ولا يُستبَعَدُ أن يكون هذا الغياب المتعمد للعلمانية أحد الأسباب البنيوية التي تجعل من التنوير الوطني مشروعاً مُعطَّلاً في ظل هذه السلطة، لأنها لا ترى في المواطنين أفراداً متساوين، بقدر ما تراهم رعايا داخل جماعة ذات هوية دينية واحدة، يحتكر فيها القائد الضرورة ومشائخ السلطة الاجتماعية والأمنية تأويل النص وتحديد المشروعية.
لهذا، فإن التنوير الوطني في سوريا لا يُمكن أن يتحقّق إلا في ظل دولة حيادية، ومجال سياسي تعددي ومجتمع سيادي يُعيد تعريف ذاته من خلال المشاركة، وليس من خلال الاحتكام إلى «الحق» المُسبَق الذي تحتكره سلطة تدّعي التكلُّمَ باسم الشريعة أو الجماعة المختارة. وكلّ سلطة تنفي هذه الشروط، أو تُفرِغها من مضمونها تحت ذريعة «الخصوصية» أو «الممانعة الثقافية»، إنما تُغلق الباب أمام أي عقل عمومي، وتُعيد المجتمع إلى دائرة الخضوع، حتى لو استعارت مفردات الثورة.
اختزال التنوير في الولاء
منذ توماس هوبز وحتى ميشال فوكو، دار الجدل في الفلسفة السياسية حول منطق الدولة ومصادر شرعيتها؛ فهل تنشأ الدولة من تعاقد بين العقلاء تفادياً للفوضى، أم أنها كما يرى فوكو، مجرد تسمية أخرى لشبكة سلطوية موزّعة، تُنتِجُ ذاتها من خلال المعرفة والخطاب والمؤسسات؟ وفي مقابل هذين التصورين، قدّمَ فيليب بيتت الدولةَ بوصفها الضامن لحرية الأفراد من الهيمنة، شرط أن توجد مؤسسات فعّالة تُقيّد السلطة وتمنعها من التحوّل إلى علاقة استعباد رمزي أو مادي.
ما يجمع بين هذه المقاربات جميعاً، هو التمييز الجذري بين الدولة كأفق تعاقدي-مُؤسَّسي يشترط وجود قاعدة قانونية مشتركة، وبين السلطة كتجسيد أحادي للقوة أو احتكارٍ للشرعية. وفي غياب هذا التأسيس التعاقدي، نشأت في الواقع أنماط سلطوية تستمد مشروعيتها من البُنى التقليدية ما قبل الحديثة، كالطائفة والعشيرة والمرجعية الدينية، فتمّت إعادة بناء الدولة كامتياز مُخصخص تُدار فيه شؤون العامة باسم الجماعة أو الزعيم.
وقد أشار محمد عابد الجابري، في نقده لبنية العقل السياسي العربي، إلى أن السلطة في التجربة التاريخية العربية لم تتأسس على مفهوم المشاركة أو التعاقد، وإنما على الغلبة والبيعة والطاعة، ما حال دون نشوء تصور للدولة بوصفها مجالاً عاماً لإرادة مدنية، وهذا ما يُبقي المجال العام مُغلَقاً أمام أي تأسيس فعلي لتنوير وطني متجذر.
هذا الانسداد البنيوي، الذي يُمكن إسقاطه على الحالة السورية، يُجسد عجزاً عن إنتاج فضاء سيادي يسمح للعقل العمومي أن يُمارس فعله السياسي المستقل، ويجعل من أي مشروع تنوير وطني محروماً من شروطه السياسية التأسيسية. فالعقل العمومي لا يُولَد من تلقاء نفسه، بل يتطلّبُ فضاءً سياسياً يعترف بتعدد الأصوات، ويمنح المجتمع حق مُساءلة السلطة دون أن يُحاصَر خطابه أو يُعاد تعريفه داخل قوالب جاهزة باسم الشرع أو الهوية أو الضرورة.
لم تُخفِ السلطة الانتقالية في سوريا موقفها الرافض لأي مشروع ديمقراطي حقيقي، وهنا نستذكر الرئيس الانتقالي المؤقت، أحمد الشرع، في خطابه الافتتاحي لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في شباط الماضي، عندما قال ونقتبس منه: «ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم مع حال البلد، ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية». ورغم أن هذه العبارة يمكن تأويلها على أنها مُوجَّهة ضد العلمانية أو التصورات الليبرالية الغربية، إلا أنها في جوهرها تنطوي على رفض مبدئي لفكرة الديمقراطية، بوصفها نظاماً قائماً على التمثيل العام، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة المتساوية. فهي تُقدَّم هنا كـ«وصفة خارجية» و«حلم سياسي مستورد»، لا كحق شعبي أو ضمانة للسيادة.
هذا الموقف وإن بدا مستنداً إلى مرجعية سلفية-جهادية تُنكر الديمقراطية باعتبارها شركاً لأنها تنقل السيادة من «الحاكمية الإلهية» إلى الناس، إلا أنه في جوهره يُعبّر عن نزعة سلطوية سنيّة متشددة أيضاً، تُعيد إنتاج الفاشية في لبوس ديني، وتُفرغ أي حديث عن المشاركة من مضمونه، عبر طقوس شكلية تُعيد تثبيت الحكم بمرجعية الحق الديني المطلق بعيداً عن أي تفويض مدني.
والنتيجة أن الشرعية السياسية تُفصَّل على مقاس «المنهج الحق»، وابتعاداً عن قاعدة الإرادة العامة، وهذا يضرب جوهر المشروع التنويري الوطني في الصميم، لأن الديمقراطية ليست مجرّد آلية انتخابية، وإنما هي التعبير المؤسساتي عن التنوير نفسه؛ فالسيادة تكون للعقل العمومي، لا للعصمة المزعومة.
حين وُلد المشروع التنويري العربي، من رفاعة الطهطاوي إلى طه حسين، سعى إلى تحديث المجتمع عبر التعليم والانفتاح على أوروبا، لكنه في أغلب لحظاته لم يتحول إلى مشروع لتأسيس دولة حديثة، فهو ظلَّ متورطاً في محاولة «إصلاح» البنى القائمة، بدل مُساءَلة شرعيتها من الأساس.
هذه النزعة لإصلاح السلطة دون مُساءَلتها تتقاطع مع ما وصفه عبده الفرجاني بـ«الحداثة الاستبدادية»، حيث تتحوّل أدوات التحديث (من تعليم وإدارة وخطاب ثقافي) إلى وسائل لإعادة إنتاج السلطة ذاتها، وليس لتفكيكها أو إخضاعها لعقل سياسي عمومي. وهي أيضاً ما أشار إليه محمد أركون حين رأى أن التنوير العربي ظلّ رهينَ خطابٍ ثقافي لم ينجح في تأسيس عقل سياسي مستقل عن مرجعيات السلطة أو العقيدة.
وفي سوريا، كان «التنوير» جزءاً من الخطاب الرسمي للبعث، لكنه خضع لإعادة تعريف صارمة، بحيث أصبح يعني الولاء للوطن الواحد القائد الفرد، وليس القدرة على مُساءَلة منطق السلطة نفسها. ولهذا أيضاً قد لا يكون غريباً أن تُنتج مرحلة ما بعد الأسد، في نسختها الأولى، سلطة تملك خطاباً شرعياً جديداً، لكنها تعيد إنتاج البنية القديمة نفسها، والمتمثلة باحتكار المعنى، وتغييب المجتمع، واستبدال القائد الملهم بالقائد الضرورة والناطق باسم الشرع.
استحالة التنوير والحق المُحتكَر
لم تُبنَ السلطة الانتقالية على تعاقد سياسي، بل اتكأت على شرعية مُفترضة دون تفويض عام. وما بدا لحظة انقطاع عن الاستبداد، كان في جوهره استمراراً له، وقد أعيد ترتيبه في خطاب ديني هذه المرة.
المفارقة أن هذه السلطة لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت على ظهر نضال طويل ضد الاستبداد. غير أنها بدلاً من أن تُعيد تعريف الشرعية بوصفها تعاقداً عاماً ينبثق من الناس، أعادت إنتاج منطق الغَلَبة بلغة شرعية، تُقصي المجتمع وتحتكر التمثيل. يتجلّى ذلك مثلاً في المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل «هيئات فرعية ناخبة» لتعيين أعضاء مجلس شعب، لا يُعرَف من ينتخبه ولا كيف، حيث تتولى اختيار ثلثي أعضاء «مجلس الشعب»، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي بقرار مباشر من الرئيس الانتقالي.
هذه الصيغة غير المسبوقة إنما تجسّد رؤية جوهرية للسلطة بوصفها صاحبة الحق الحصري في تعريف الشعب وتمثيله والتكلم باسمه. في هذه الحالة لا تعود الدولة هنا أفقاً للتعاقد العام، وإنما تكتفي بأن تكون مساحة مخصصة للولاء. وهو ما يلتقي مع مقاربة إرنستو لاكلو، الذي رأى أن أخطر أشكال السلطة يكمن في احتكار تعريف «الشعب» ذاته، وفرض تمثيل واحد مغلق له باسم «الهوية الجامعة» أو «المنهج الحق»، ففي مثل هذه السياقات يُعاد إنتاج التمثيل كحقيقة مسبقة وليس كعملية ديمقراطية مفتوحة.
لا يمكن الحديث عن التنوير الوطني في ظل سلطة تُعيد تعريف الدولة خارج مفهوم المشاركة، وتُقصي المجتمع من أي فعل تأسيسي حقيقي، فهذه السلطة لم تُطلق عقداً سياسياً ناجزاً، ولم تفتح المجال لتعدد الإرادات، في وقت احتكرت فيه وظيفة التمثيل، وحددت ما الذي يُعتبَر شرعياً. في هذا السياق يكون التنوير الوطني مستحيلاً، لأن شروطه التأسيسية؛ من عقل عمومي ومجال مفتوح ونقاش مشروع، قد جرى استئصالها من الجذور.
لا يمكن فهم التنوير في السياق السوري الحالي بوصفه نشاطاً ثقافياً معزولاً أو خطاباً نخبوياً يدور في حلقات محدودة، فالتنوير في لحظات الانقطاع التاريخي لا يكون فعل مراجعة فكرية، وإنما فعل تأسيس سياسي. إنه إعادة طرح للسؤال الجوهري؛ من يملك الدولة وبأي حق تُمارَس السلطة؟ وهو ما يقترب من طرح مارسيل غوشيه، الذي رأى أن نشوء الدولة الحديثة يقوم على «نزع السحر عن السلطة»، بحيث يُعاد تعريف الشرعية من امتدادٍ لوحي أو تقليد إلى عقدٍ خاضعٍ للمُساءلة الدائمة. وفي سياقنا السوري اليوم، تتم استعادة سحر السلطة بصيغة شرعية مغلقة، يمكن أن تُحوّل المجتمع إلى مُتلقٍّ أبدي لمعنى مفروض.
هنا لا يعود التنوير مشروعاً لتثقيف المجتمع، بقدر ما يكون لاستعادة السياسة من يد السلطة، بوصفها احتكاراً للمعنى والتمثيل. حيث ينشأ التنوير حين يُعاد تشكيل العقد الذي يربط بين الدولة والمجتمع على قاعدة المشاركة، وعلى أساس المواطنة. ولهذا تكمن المشكلة في الشكل الذي تُنظَّم به السلطة، وفيما إذا كانت الدولة تُبنى بوصفها مُلكاً عاماً أم تُعاد هندستها كامتياز جماعي مغلق.
وبهذا المعنى، لا يكون التنوير تصحيحاً لخطاب السلطة، ولا إصلاحاً لممارساتها، وإنما يكون مُساءلة جذرية لبنيتها نفسها، وما إذا كانت تصلح أن تكون أساساً لمجتمع حرّ، أو مجرد امتداد مُقنّع لاستبداد قديم، بلغة جديدة. لا يُطرح التنوير هنا بوصفه خصماً للدين أو مهدّداً للهوية، وإنما بوصفه حاجزاً مفاهيمياً أمام احتكار المعنى، أياً تكن المرجعية التي تدّعيه. فالتنوير لا يرفض المقدّس، وإنما يرفض توظيفه لإقصاء المجتمع وتعطيل السياسة.
ختاماً، لا بد لنا من الانتقال من الطرح التحليلي النقدي إلى استشراف ملامح الفعل الممكن. فالتنوير الوطني لا يمكن أن يُختزَل في كونه موقفاً نقدياً أو فعلاً ثقافياً طارئاً، بل يُمكن أن يتبلور بوصفه اتجاهاً اجتماعياً متنامياً، وحركة فكرية تسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس عقلانية ومشتركة. ومن رحم هذا المسار، قد تتكون ملامح مشروع تأسيسي جديد لا يقتصر على المجال الثقافي، وإنما يطال البنية السياسية ذاتها.
لا يستلزم تحقق هذا التنوير الوطني انقلاباً في موازين القوة، بقدر ما يتطلب تراكم الوعي في الهامش، وتوسيع فضاءات القول والفعل، وخلق شبكات مدنية مستقلة تستعيد المجال العمومي وتُعيد تعريف المشاركة والتمثيل. في هذه المساحات الرمادية، لا بد أن تُصاغ البدائل بعيداً عن منطق الوصاية، ما يساهم في نشوء نواة عقل عمومي جديد، وبدء ملامح الدولة المؤجلة بالتشكل.
بهذا المعنى، يُولد التنوير الوطني من فعل التأسيس الصبور في الهامش، ومن مقاومة رمزية تسعى إلى نزع القداسة عن السلطة، وإعادة السيادة إلى المجتمع باعتباره المصدر الأول للمعنى والشرعية.
الجمهورية نت