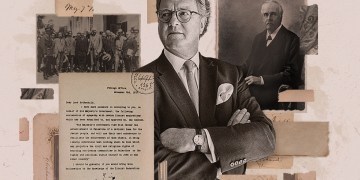ملخص تنفيذي
تُقيّم هذه الورقة مسار التحالف ضدّ تنظيم “داعش”، بمراحله المختلفة، منذ 2014، من حيث إنه ترتيب متعدد الأطراف جمَع بين التفوّق العسكري والتمكين المحلي، حيث تمكّنت قوات التحالف من تفكيك السيطرة الإقليمية للتنظيم بحلول عام 2019، وقضت على نفوذه وانتشاره ونقاط إمداده، وتركت قيادات التنظيم وعناصره بين قتيل ومعتقل وفارّ، لكنّ عمليات التحالف بالمقابل خلّفت كلفة إنسانية باهظة، حيث دُمّرت كثير من البنى التحتية والمنشآت الحيوية التي كان يستخدمها التنظيم، فضلًا عن الضحايا من المدنيين، ومئات الآلاف من المهجّرين من بيوتهم والمتضررين بسبب تلك العمليات، وما يزال الآلاف منهم خارج بيوتهم في مناطق عدة شرقي الفرات، حتى بعد طيّ صفحة التنظيم. وكل هذه النتائج توجب طرح الأسئلة حول مسألة السيادة وترتيبات الحكم في سورية.
وتسدّ الدراسة فجوةً بحثية، إذ تدمج بين ديناميات التحالفات والحرب بالوكالة وتحوّلات السيادة، وتقيّم سيناريو انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضد داعش، بعد التغيير السياسي، كفرصة للاعتراف والدعم الأمني والاستقرار وإعادة الإعمار، وتناقش تحديات إعادة هيكلة المؤسسات، والعلاقة بقسد، ومستقبل التنف، والتباينات داخل التحالف، وحدود القرار السيادي، مع استمرار تهديد الخلايا وملفّ المقاتلين الأجانب. وتخلص الدراسة إلى أن الجدوى مشروطة بتقديم مقاربة متدرجة، توازن بين متطلبات الأمن الجماعي، وترسيخ السيادة الوطنية.
أولًا: مقدمة
يُعدّ صعود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بين عامَي 2013 و2014 نقطةَ انعطافٍ أمنية–سياسية ذات أثرٍ عابر للحدود في المشرق العربي، بلغ ذروته بإعلان “الخلافة”، والسيطرة على مساحات واسعة في سورية والعراق. وقد استدعى ذلك تشكيلَ “التحالف الدولي لهزيمة داعش”، بقيادة الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2014، كترتيبٍ متعدد الأطراف يزاوج بين التفوّق الجوي والتمكين المحلي، ويتجاوز المقاربة العسكرية الضيقة إلى حزمة أدواتٍ أمنية–قانونية–إعلامية. وقد اعتمد التحالف منذ تشكيله على نموذج التحالفات المحلية، فدعم الجيش العراقي والبيشمركة في العراق، واعتمد في سورية على قوات (قسد)، وعلى فصيل “مغاوير الثورة” في التنف، وقد أدى ذلك إلى هزيمة التنظيم، واستعادة مدن كبرى كالرقة ودير الزور، من قبضته. واتسمت العلاقة بين التحالف والنظام السوري السابق بالتناقض، ما خلق حالة من “التعايش العدائي” بين الطرفين، وقد أظهر هذا الواقع الملتبس إشكالية السيادة في سورية، حيث تداخل الأمني بالسياسي، والداخلي بالدولي، لتصبح مكافحة الإرهاب ساحةً لإعادة تعريف دور الدولة وحدود نفوذها، ما طرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي في مرحلة ما بعد داعش، ومدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على استعادة سيادتها، والانخراط في المنظومة الأمنية العالمية من دون التفريط بسيادتها.
تنطلقُ هذه الورقة من نقطة بحثية مفادُها أنّ الأدبيات التي قاربت هذا الموضوع كانت تركّز على قراءةٍ عملياتية لحملة التحالف، أو على سرديةٍ جيوسياسية عامة، مع محدودية الدراسات التي تدمج بين ديناميات التحالفات متعددة الأطراف والحرب بالوكالة وتحولات السيادة في الحالة السورية. ومن ثم، تسعى الدراسة إلى عدة أمور: (1) توصيفٍ تحليلي لتشكّل التحالف وتطوّره (2014–2025)؛ (2) تفكيك أثره العسكري–السياسي على ترتيبات الحوكمة والأمن شرق الفرات وخارجه؛ (3) تقويم سيناريو انضمام سورية إلى التحالف بعد التغيّر السياسي، من زاويتَي الكلفة–المنفعة ومآلات السيادة.
ومن ثم، تجيب الورقة عن سؤالَيْن رئيسين: كيف أعاد التحالف تشكيلَ معادلة القوة والسيادة في سورية؟ وما شروطُ وجدوى إدماج الدولة السورية الجديدة طرفًا شريكًا ضمن معماريته المؤسسية؟ وتعتمد الورقةُ، منهجيًا، تحليلًا وثائقيًا مقارنًا لبيانات التحالف وقرارات مجلس الأمن وبيانات الدول الأعضاء، مكمَّلًا بــتتبّعٍ سببيٍّ لسلاسل القرارات والنتائج العملياتية في معارك مفصلية (عين العرب/ كوباني، الرقة، الباغوز)، مع توظيف إطارٍ مفاهيمي يستند إلى نظريات التحالفات، والاعتماد على الوكلاء، والسيادة المتدرجة.
ثانيًا: تشكيل التحالف الدولي وأعضائه
بعد أن تحوَّلت الثورة السورية إلى نزاع مسلّح تعدّدَ الفاعلون فيه، انفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال حالة الفوضى، وترسيخ وجودها داخل البلاد، فولد تنظيم “داعش” من رحم تنظيم القاعدة في العراق، وبدأ بالتمدد، وبحلول عام 2014، كان قد بسط سيطرته على مناطق واسعة في سورية والعراق، ومارس أبشع أنواع الانتهاكات، مستهدفًا مختلف المكوّنات الدينية والمذهبية. وفي حزيران/ يونيو 2014، شكّل اجتياح الموصل وإعلان قيام ما سُمّي بـ “الخلافة الإسلامية” نقطةَ تحوّل خطيرة أثارت قلق المجتمع الدولي، الأمر الذي مثّل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن الجماعي في الشرق الأوسط.
دفعَت هذه التطورات الولايات المتحدّة إلى تبنّي مقاربة “التحالفات المرنة”، ففي 10 أيلول/ سبتمبر 2014، أعلن الرئيس أوباما تأسيس “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، وضم التحالف في بدايته 12 دولة، قبل أن يتوسع مع نهاية العام، ليشمل نحو 60 دولة في كانون الأول/ ديسمبر 2014. ومع الوقت، بلغ عدد أعضائه 89 دولة، بالإضافة إلى منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأنشأ التحالف “قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب”، التي تعمل مع سبعة وعشرين دولة، ووفّر مجلس الأمن غطًاء قانونيًا عبر القرار رقم 2249 الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 [1]، الذي دعا الدولَ القادرة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، مستندًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (الدفاع الجماعي) التي تتيح حق الدفاع الجماعي، وإلى الالتزام الدولي بمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
بدأت العمليات التحالف العسكرية فعليًا في 8 آب/ أغسطس 2014، عبر ضربات جوية أميركية ضد مواقع التنظيم في العراق، ثم امتدت إلى سورية في 23 أيلول/ سبتمبر 2014، حيث نُفذت أولى الغارات على معاقل التنظيم في سورية، وكانت بمشاركة دول عربية عدة، منها السعودية والإمارات والأردن والبحرين[2]. وقد ساهمت تلك الضربات في وقف تقدّم التنظيم، وأظهرت جدية المجتمع الدولي في التصدي له. وقد خسر التنظيم، بين عامي 2014 و2017، نحو 95% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 2017، كان التنظيم قد فقد السيطرة على كامل الأراضي في العراق.[3]
رحّبت الحكومة العراقية بتدخل التحالف، باعتباره مبنيًا على طلب رسمي منها، في حين كان الوضع في سورية أكثر تعقيدًا، حيث أعلن النظام السوري دعمه لأي جهد دولي لمحاربة الإرهاب، زاعمًا أنه يُبلّغ مسبقًا بالعمليات الجوية، في حين كانت أميركا تنفي أيّ تنسيق مباشر مع النظام السوري، أما روسيا وإيران حليفا لنظام السوري، فاعتبرتا أن الضربات الجوية تمثل انتهاكًا للسيادة السورية، لعدم صدورها بقرار من مجلس الأمن أو بموافقة الحكومة السورية[4].
واصل التحالف توسعه ونشاطه العسكري، ففي عام 2015، انضمت قوى غربية جديدة إلى العمليات في سورية، بعد أن كانت مشاركتها مقتصرة على العراق، ومن أبرزها فرنسا وبريطانيا، وأعلنت تركيا انضمامها رسميًا إلى التحالف، لكنها ظلت متحفظة في مشاركتها، خلال المرحلة الأولى، إذ أولت أولوية لمواجهة قوات PYD/PKK على حدودها.
تميّز التحالف الدولي بتنوّع عضويته، إذ ضمّ عشرات الدول، لكلٍّ منها مساهمة خاصة عسكرية أو لوجستية أو غيرها، وشكّلت بمجموعها منظومة متكاملة لمواجهة التنظيم. وتُعدّ الولايات المتحدة القوة المحرّكة والمحور الرئيس في قيادة التحالف، أما بريطانيا التي تُعدّ ثاني أكبر مساهم عسكري، فقد اقتصرت ضرباتها بداية على العراق، قبل أن يوافق البرلمان على توسيعها لتشمل سورية في أواخر عام 2015، أما فرنسا فقد بدأت غاراتها في العراق، في أيلول/ سبتمبر 2014، وانضمت إلى العمليات في سورية نهاية عام 2015. وعلى الصعيد السياسي، تبنّت هذه الدول وسائر دول التحالف الدعوة إلى حل سياسي في سورية، ليتم التفرغ لمحاربة التنظيم[5].
تبنّت تركيا في البداية موقفًا حذرًا تجاه التحالف، بسبب تعقيدات الملف السوري، وبسبب مخاوفها من تصاعد نفوذ PYD/ PKK على حدودها، وفي آب/ أغسطس 2016، أطلقت عملية “درع الفرات”، مستهدفةً تنظيم “داعش”، وتمكّنت مع الفصائل السورية المعارضة من طرده من جرابلس والباب. ورغم الخلافات مع واشنطن بشأن دعم وحدات PYD، ظلت تركيا شريكًا أساسيًا في التحالف، وشاركت عدة دول عربية في التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن والبحرين وغيرها، ونفّذت طلعات جوية إلى جانب التحالف عام 2014 مستهدفة مواقع “داعش” في الرقة ودير الزور[6]. بهذا المعنى، لم يكن التحالف الدولي مجرد تحرك عسكري طارئ، بل آلية مؤسسية لإعادة تعريف الأمن الإقليمي، وترتيب موازين القوى في مرحلة ما بعد “الخلافة”.
ثالثًا: الدور العسكري والسياسي للتحالف
كانت العمليات العسكرية الركيزة الأساسية لاستراتيجية التحالف، حيث اعتمد على حملة جوية مكثفة استهدفت مراكز التنظيم، وقامت على استخدام التفوق الجوي والتقنيات المتطورة لتقليل الحاجة إلى نشر قوات برية بأعداد كبيرة، فكانت الطائرات الحربية تنفّذ الغارات ضد مقارّ القيادة ومعسكرات التدريب ومستودعات الأسلحة والبنى التحتية الاقتصادية التي اعتمد عليها التنظيم في تمويل عملياته، مثل منشآت النفط والغاز، ومثّلت هذه الضربات عنصر الحسم في إيقاف تمدّد “داعش”، وتهيئة الأرضية لتحرك القوات المحلية على الأرض، حيث اعتمد التحالف على تمكين القوى المحلية لتكون رأس الحربة في المواجهة البرية، مع إسناد دولي جوي ولوجستي واستخباراتي، ففي العراق، تولّى تدريب الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية ووحدات العشائر، ما ساعد في إعادة تأهيلها ورفع جاهزيتها القتالية، وفي سورية شكّلت قوات “قسد” الشريكَ المحلي الرئيس للتحالف، وبدأ دعم التحالف لها منتصف عام 2015، عبر تزويدها بالسلاح والتدريب والمستشارين، وتوفير غطاء جوي مباشر لعملياتها، وقد انتصر التحالف مع قسد في عدة معارك، أبرزها معركة عين العرب (كوباني) مطلع عام 2015، التي مثّلت أول هزيمة كبرى لـ “داعش” على الأرض، وذلك بفضل الضربات الجوية المكثفة التي غيّرت موازين المعركة، وفي آب/ أغسطس 2016، سيطرت قسد على مدينة منبج، بعد معارك عنيفة.
وشكّلت معركة الرقة عام 2017 ذروة التنسيق العسكري، بين التحالف وقسد، حيث وفّر التحالف غطاءً جويًا ومدفعيًا كثيفًا طوال المعركة، وبالرغم من مقاومة عناصر “داعش” الذين استخدموا المدنيين دروعًا بشرية، تمكنت قسد من السيطرة على المدينة، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وكانت المعركة حاسمة لكنها خلفت دمارًا واسعًا وخسائر كبيرة بين المدنيين، ثم استمرت العمليات ضد بقايا التنظيم حتى سقوط آخر معاقله في بلدة الباغوز، في 23 آذار/ مارس 2019[7]، وهو التاريخ الذي أعلن فيه التحالف رسميًا نهاية السيطرة الإقليمية للتنظيم في سورية.
وحرص التحالف على تقليل خسائره البشرية، فلم ينشر قوات برية كبيرة، مكتفيًا بانتشار محدود لقوات العمليات الخاصة الأميركية والبريطانية والفرنسية، وتولّت هذه الوحدات مهام تنسيق الضربات الجوية وتوجيه القوات المحلية، لذلك كانت الخسائر البشرية في صفوف التحالف محدودة جدًا، مقارنة بالحروب التقليدية، وقد أسفر اعتماد التحالف المكثّف على القصف الجوي والمدفعي عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وعن دمار أحياء بكاملها، وتُبرز معركة الرقة عام 2017 حجم الثمن المدفوع، إذ قُتل فيها ما لا يقل عن 1600 مدني، مع تحوّل المدينة إلى أحد أكثر مسارح الدمار حدّة في الحقبة الحديثة، وتشير تقديرات إلى أن إجمالي الضحايا المدنيين من جراء عمليات التحالف في سورية والعراق قد يراوح بين 8 آلاف و13 ألفًا[8]، وقد أقرّ التحالف بمسؤوليته عن نحو 1450 حالة فقط، فضلًا عن نزوح الآلاف خلال العمليات[9].
وعلى المستوى الإنساني، خلّفت العمليات تحديات متعدّدة، أبرزها ملف مقاتلي التنظيم وعائلاتهم المحتجزين في شمال شرق سورية، حيث يضمّ مخيم الهول عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمقاتلين الأجانب. ويشكّل هذا الملف اختبارًا لاستدامة النصر العسكري، إذ تبيّن التجربة أن إهمال البعد الإنساني والقانوني يُعيد إنتاج الظروف المولِّدة للتطرّف.
ولم تقتصر جهود التحالف على القتال المباشر، بل شملت جملة من الإجراءات المساندة لضمان هزيمة “داعش” على المدى الطويل، من أبرزها منع تدفق المقاتلين الأجانب، وتجفيف مصادر تمويل التنظيم، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الأولي، ومكافحة الدعاية المتطرفة.وبفضل هذه المقاربة، نجح التحالف في القضاء على الوجود الإقليمي للتنظيم، والحد من قدرته على التخطيط للهجمات أو تجنيد المقاتلين، وأسهم ذلك في إعادة تشكيل المشهد الأمني في سورية والعراق والمنطقة بأسرها.
أما في البعد السياسي، فقد تجاوز التحالف كونه إطارًا عسكريًا إلى أداةٍ لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية والمحلية في سورية، إذ مارس ضغطًا غير مباشر على النظام السوري وحلفائه، وأسّس لتقاسم نفوذ فعلي بين شرق الفرات وغربه، وأُدير هذا الواقع عبر آلية منع الاشتباك التي أنشئت بين القيادتين الأميركية والروسية، لتجنّب التصادم الجوي، ما عكس مستوًى من البراغماتية التفاعلية بين القوى الكبرى رغم تناقض أجنداتها. ومنذ بداية الحملة على التنظيم، شددت الدول الرئيسية في التحالف على أن الحرب على الإرهاب لا يمكن فصلها عن الحاجة إلى حل سياسي شامل في سورية، وقد أكدت هذه الدول، في بياناتها المشتركة المتكررة، أن القضاء على الإرهاب يجب أن يترافق مع عملية انتقال سياسي تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2254[10]. وأكدت في بيانات عدة -كان أبرزها بيان عام 2023- أن القرار 2254 هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع السوري، مجددةً التزامها بتطبيق جميع بنوده المتعلقة بالانتقال السياسي، ووقف إطلاق النار، وصياغة دستور جديد يمثل جميع السوريين[11].
وتبنّى التحالف مقاربة واقعية فصلت بين مهمته العسكرية ضد “داعش”، وبين الصراع بين النظام والمعارضة، حيث ركّز عملياته حصريًا على مواجهة التنظيم، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع قوات النظام السوري، تفاديًا لأي تصعيد مع روسيا وإيران، وقد أثار هذا الموقف خلافات داخل التحالف نفسه، إذ طالبت بعض الدول منذ وقت مبكر بضرورة تطبيق القرار 2254، بالتوازي مع محاربة التنظيم، وتمسكت أميركا وحلفاؤها الأوروبيون بتجنّب المواجهة المباشرة مع النظام، لكن واصلت عزله سياسيًا واقتصاديًا، فقد رفضت أميركا والدول الأوروبية أي تطبيع مع نظام الأسد أو المشاركة في إعادة الإعمار، ما لم يتحقق تقدم ملموس في العملية السياسية. وتشكلت “المجموعة المصغّرة حول سورية”، التي ضمّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، كمنصة موازية لتنسيق المواقف الدبلوماسية ودعم المعارضة السياسية، بالتوازي مع الدور العسكري ضد “داعش”[12].
وواجه التحالف منذ بدايته توترًا مع روسيا وإيران، اللتين اعتبرتا وجوده في سورية غير شرعي، لغياب تفويض من مجلس الأمن، ولعدم تنسيقه مع حكومة النظام السوري، ومع التدخل العسكري الروسي في أواخر أيلول/ سبتمبر 2015، تغيّر ميزان القوى على الأرض، وازدادت احتمالات الاحتكاك المباشر بين الطائرات الروسية وتلك التابعة للتحالف، خاصة في الأجواء الشمالية والشرقية من سورية، وأصبح وجود التحالف عقبة أمام طموحات روسيا وإيران في توسيع نفوذ النظام السوري، هذا الواقع أفرز نوعًا من تقاسم النفوذ غير المعلن: مناطق شرق الفرات تحت مظلة التحالف، وغربها وجنوبها تحت سيطرة النظام السوري وحلفائه. ولمنع أي تصادم، أنشأ الجانبان الأميركي والروسي آلية “منع الاشتباك” (De-confliction) عبر خط اتصال مباشر بين قيادتيهما العسكريتين، لتبادل الإحداثيات وتفادي الحوادث الجوية، وقد أثبتت هذه الآلية فعاليتها في عدة مواقف أبرزها حادثة إسقاط مقاتلة أميركية لطائرة سورية من طراز Su-22 قرب الطبقة عام 2017[13].
وغذّى الوجود العسكري لا سيما الأميركي في مناطق عقدية على طريق طهران–بيروت البري استقطابات جديدة، فإيران وجدت نفسها أمام انتشار أميركي يقيّد مشروعها الإقليمي، ليتشكل نمط من “الاستنزاف المنضبط”: هجمات صاروخية ومسيّرة لميليشيات حليفة ضد قواعد التحالف شرق سورية، تقابلها ضربات أميركية موضعية لردعها، ضمن حدود مدروسة لا تنزلق إلى مواجهة شاملة، حيث تعرّضت القواعد الأميركية في شرق سورية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ أطلقتها ميليشيات مدعومة من إيران، خصوصًا في الأعوام 2020–2023، وردت أميركا بضربات جوية محدودة، استهدفت مواقع تلك الميليشيات[14].
وعلى الرغم من التباين في المواقف، اتسمت العلاقة بين التحالف وروسيا وإيران بقدر من البراغماتية، فقد أدرك الطرفان أن تجنب الصدام المباشر يخدم مصالحهما المشتركة في استقرار خطوط التماس، ومع ذلك، ظل الخلاف حول مستقبل سورية قائمًا؛ فالتحالف لم يمنح أي اعتراف بشرعية التدخل الروسي أو بسيادة النظام السوري الكاملة، في حين واصلت ورسيا وإيران دعم الأسد سياسيًا وعسكريًا في مسعًى لتكريس انتصاره الداخلي.
أما تركيا، فدفعها خلافها مع أميركا بشأن دعم “قسد” إلى إعادة تموضع سياسي وتقارب أكبر مع موسكو بعد 2016، والعمل ضمن مسار آستانة لترتيب ملفات عديدة، وانعكس ذلك على تماسك التحالف في بعض المحطات، مع بقاء تركيا لاعبًا لا يمكن تجاوزه، لاعتبارات الجغرافيا واللوجستيات والحدود واللاجئين.
في المحصلة، يعكس أداء التحالف الدولي نموذجًا لتطور العمل الجماعي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، إذ جمع بين الأدوات العسكرية والأمنية والسياسية، ضمن هيكلٍ مرنٍ غير مؤسسي. وبالرغم من نجاحه في إنهاء التهديد الإقليمي المباشر لتنظيم “داعش”، فقد أنتج واقعا جيوسياسيًا مركّبًا، أعاد رسم حدود النفوذ والسيادة في سورية، ورسّخ مقاربة “الأمن عبر الوكلاء”، بوصفها إحدى سمات النظام الأمني الشرق أوسطي الجديد. وهكذا أعاد التحالف الدولي تشكيل المشهد السوري داخليًا، عبر إنهاء سيطرة “داعش” وخلق ترتيبات محلية جديدة شرق الفرات، لكنه ترك تحديات إنسانية وأمنية صعبة، وفتح الباب أمام تنافسات إقليمية مستمرة، وعلى المستوى الأوسع، رسّخ التحالف نمطًا براغماتيًا للتعامل مع تهديدات عابرة للحدود، جامعًا بين التفوق العسكري وأدوات الاستقرار والسياسة، ومكرّسًا موازين قوى جديدة في الشرق الأوسط لا تزال مآلاتها مفتوحة على احتمالات متعددة. ومن ثم، مثّل التحالف إطارًا يجمع بين الأهداف الأمنية قصيرة المدى والأهداف السياسية بعيدة المدى، جامعًا بين محاربة الإرهاب والحفاظ على التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
رابعًا: انضمام سورية للتحالف الدولي
بعد سقوط نظام الأسد، بدأ الحديث عن انضمام سورية للتحالف، وقد أكّد المبعوث الأميركي إلى سورية أن الحكومة الانتقالية ستوقّع، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اتفاقية الانضمام لتصبح الدولة العضو رقم 90 في التحالف، ما يُمثّل تحولًا دبلوماسيًا بنيويًا في علاقات سورية مع الغرب، بعد عقودٍ من الارتباط بالمحور الشرقي”[15]، لتكون الدولة رقم 90 في هذا التحالف، وللمرة الأولى تكون سورية طرفًا في التحالف، ويعكس هذا في حال تحققه نجاح الإدارة السورية في أن تكون شريكًا موثوقًا ضمن التحالفات الأمنية والإقليمية، بعد أن تقدّمت بالطلب بدفع من فرنسا وألمانية والسعودية في كانون الثاني/ يناير 2025، وترك الطلب الأول معلقًا من دون ردّ رسمي، ويبدو أن ذلك كان بغرض اختبار مدة قدرة سورية على تلبية الشروط المطلوبة، وجاء الطلب الثاني بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
يُعدّ انضمام سورية إلى التحالف الدولي خطوةً قد تحقق للإدارة السورية مايلي:
- الشرعية والاعتراف الدولي، حيثيشكّل الانضمام اعترافًا رسميًا بشرعية الحكومة الانتقالية، ويعيد تموضعها من محور المقاومة إلى شبكة التحالفات الغربية، ما يفتح الباب لرفع تدريجي للعقوبات والانخراط في برامج الاستقرار وإعادة الإعمار.
- إعادة هندسة العلاقة مع الفاعلين المحليين، حيث يمثّل التعاون المباشر بين التحالف والجيش السوري الجديد بداية مرحلة ما بعد الوكلاء، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى تقليص اعتماد التحالف على “قسد” ودمجها تدريجيًا ضمن بنية الدولة، مع الحفاظ على دورها الأمني في المناطق الشمالية الشرقية، عبر ترتيبات ثلاثية (دمشق–قسد–التحالف)، يمكن للتحالف أن يقدم دعمًا تقنيًا ولوجستيًا أكبر للجيش السوري الجديد عبر برامج التدريب والتسليح النوعي والمساندة الاستخباراتية، بما يعزز قدرته على ضبط الأمن وملاحقة بقايا التنظيم.
- يوفّر التعاون الرسمي قاعدة قانونية لانخراط أوسع في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وبالرغم من المكاسب المتوقعة، يواجه مسار انضمام الحكومة السورية إلى التحالف الدولي جملةً من التحديات:
- تحديات داخلية: حيث ما زالت مؤسسات الجيش والأمن في سورية الجديدة في طور إعادة التشكّل، وقد ظهرت بعض الثغرات في التدقيق الأمني للمنتسبين الجدد، وهناك وجود لبعض الأجانب في هيكلية القيادة العليا في الجيش، مع ضعف القدرات التقنية واللوجستية، ما قد يثير تساؤلًا لدى بعض شركاء التحالف بشأن جاهزية القوات لعمليات مشتركة واسعة، ويبرز أيضًا هاجسُ الانضباط والولاء داخل الأجهزة، والحاجة إلى تسريع إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية على أسس مهنية.
- ملف “قسد”: حيث كانت (قسد)، منذ عام 2015، الشريك المحلي الأساسي للتحالف الدولي، واعتبر التحالف الدولي هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للقتال عبر “قوة محلية مدعومة دوليًا”، بعيدًا عن نشر قوات برية أجنبية موسعة، ورسّخت قسد بدعم التحالف هياكل حكم وأمن محلية شرق الفرات، لِتدير شؤون السكان بحكم الأمر الواقع. وقد أثار ذلك حساسية تركيا، فتدخّلت عسكريًا بعمليتي غصن الزيتون (2018)، ونبع السلام (2019)، ما أحدث شرخًا داخل صفوف شركاء التحالف، وفرض ترتيبات ميدانية جديدة، شملت إعادة انتشار لقوات النظام والشرطة العسكرية الروسية في بعض المناطق.
وفي حال انضمام سورية إلى التحالف، قد يبرز تحوّلٌ في المشهد، إذ من المنتظر أن تنخرط الحكومة الجديدة رسميًا في العمليات ضد بقايا “داعش”، وهو ما يُعيد الاعتبار للجيش والمؤسسات الأمنية السورية كشريك شرعي مباشر للتحالف، هذا الواقع المستجد يضع العلاقة مع “قسد” أمام مرحلة انتقالية دقيقة، فمن جهة، ترى “قسد” في هذا التحول تهديدًا لوجودها المستقل، سياسيًا وعسكريًا، وتخشى أن يؤدي التنسيق المباشر بين التحالف ودمشق إلى تهميش دورها أو الضغط لحلّها ودمجها في أجهزة الدولة، من دون ضمانات كافية، وأميركا لا تزال تثمّن دور “قسد” كشريك فعّال وموثوق، لكن انخراطها مع حكومة سورية يفرض عليها إعادة ضبط أولوياتها وشبكة تحالفاتها، ولذلك تسعى إلى لعب دور الوسيط بين “قسد” ودمشق، بهدف التوصل إلى ترتيبات توافقية، تضمن الحفاظ على الجاهزية القتالية ضد الإرهاب مع تهيئة الأرضية لدمج منضبط ومنظم لقسد ضمن بنية الدولة، فالتحدي أمام التحالف الآن هو الموازنة بين التزامه تجاه “قسد”، وبين تعاونه مع حكومة تسعى لاستعادة سيادتها الكاملة، وأي انزلاق نحو الإقصاء أو المواجهة بين الطرفين قد يُضعف الجبهة المشتركة ضد “داعش”، ولذلك، فإن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب عملية دمج قائمة على شراكة ثلاثية، بين الحكومة وقسد والتحالف، تُعالج التحديات الأمنية والسياسية بمراعاةٍ دقيقة لحساسيات الأطراف كافة.
- مصير التنف: مثّلت قاعدة التنف، منذ عام 2016، مركزًا استراتيجيًا للتحالف الدولي، حيث تمركزت فيها قوات أميركية وقوات خاصة من دول غربية، وأنشأ التحالف ضمن هذه القاعدة فصيلًا محليًا تحت مسمى “جيش سوريا الحرة”، درّبته ووفّرت له غطاءً جويًا ودعمًا لوجستيًا للقيام بعمليات أمنية محدودة ضد خلايا “داعش” في البادية السورية، وحافظ “جيش سوريا الحرة” على علاقة وثيقة مع التحالف الدولي، وظلّ يعمل ضمن منطقة بمساحة 55 كم حول قاعدة التنف، وفي حال انضمام سورية إلى التحالف، ستجد أميركا نفسها أمام خيار مراجعة وجودها في التنف، بعدما باتت تتعاون مع حكومة شرعية جديدة في دمشق يُفترض أن تستعيد السيطرة على كامل الأراضي السورية، ومن المرجّح أن يُوظّف “جيش سوريا الحرة” كـقوة وسيطة ضمن عملية إعادة الهيكلة الأمنية، وخاصة بعد دمجه بالجيش الجديد، لا سيما أنه يضم مقاتلين يملكون خبرة ميدانية في مكافحة “داعش”. ويُرجّح أن تعتمد واشنطن سياسة “الانتقال التدريجي” في إدارة ملف التنف، بحيث لا تُنهي دعمها للفصيل فجأة، بل تسعى إلى تسوية ترتكز على تفاهمات أمنية مع دمشق، تتيح دمجه ونقله لمهام جديدة، وربما إعادة تعريف دور القاعدة نفسها في ظل المعادلة الجديدة، هكذا، سيكون مستقبل التنف اختبارًا لإرادة التعاون بين التحالف ودمشق، وقدرتهما على تحويل أدوات الحرب إلى أدوات للدولة، في سياق محاربة مشتركة لـ “داعش” وترسيخ سيادة وطنية شاملة.
- التباينات داخل التحالف الدولي: تختلف الأولويات بين العواصم، رغم وحدة الهدف العام، فتركيا تركز على تهديد قسد، في حين يحصرُ شركاء آخرون الجهد في “داعش”، ويعدّون بقية الملفات سياسية الطابع، وقد ينعكس ذلك على تصميم العمليات وتقاسم الأعباء، ومن ثم قد تظهر فجوات، إذا توسّع نطاق العمليات إلى مناطق خلافية أو تزايدت مخاطرة الاحتكاك مع قوى غير منضوية في التحالف، فالحفاظ على التماسك يتطلّب آلياتِ تنسيقٍ دقيقة، وخطوط اتصال مفتوحة لتفادي الحوادث، ومواءمة مستمرّة بين أجندة الحكومة السورية وأولويات الشركاء.
- مطالب التحالف: يقترن انضمام سورية للتحالف بمطالب تتعلق بالتنسيق العسكري والاستخباراتي ضمن منظومة التحالف، بما يفرض على دمشق الالتزام بقواعد ميدانية، لا تتوافق بالضرورة مع أولوياتها الداخلية، ويمكن أن يحدّ هذا التعاون من حرية القرار الأمني السوري، خصوصًا في حال طُلب منها الامتناع عن استهداف أطراف محسوبة على التحالف أو القبول بترتيبات مراقبة مشتركة.
- موقف الدول الغربية: قد ترى بعض الدول الغربية في هذا التعاون وسيلةً للضغط من أجل تغييرات في بنية السلطة، أو إعادة توجيه السياسات الأمنية السورية، وهكذا يصبح الانضمام إلى التحالف معادلة معقدة، بين رغبة سورية في استعادة الاعتراف الدولي، وحاجتها إلى الحفاظ على استقلالها السيادي في إدارة شؤونها الأمنية والسياسية، أي أن الفائدة المرجوة مشروطة بمدى قدرة الدولة على التوفيق بين التعاون الخارجي ومتطلبات السيادة الداخلية [16].
- تهديدات “داعش” وردّات فعل المتطرفين: حيث تحوّل التنظيم إلى شبكة خلايا مرنة غير مركزية، تنتشر في البادية وفي مناطق حدودية، وتنفّذ تكتيكات خاطفة[17]، وفي ظل الترتيبات الجديدة، قد يسعى التنظيم لتصعيد عمليات التخريب، لإظهار هشاشة الشراكة الوليدة، كما قد تنشط خلايا “الذئاب المنفردة” أو جماعات متطرفة أخرى، لاستهداف مؤسسات الدولة وتقويض الثقة بين الشركاء، فقد تطوّر التنظيم من هيكل هرمي إلى نمط لا مركزي، ما يصعّب رصده والرد عليه.
- مصير القوات الأميركية والقوات الأجنبية في سورية: حيث إن من المنتظر بعد توقيع الاتفاق أن يكون في الفترة القادمة اتفاقات حول مصير القواعد الأميركية في سورية، وغيرها من القواعد الأجنبية.
- ملف المقاتلين الأجانب (ولا سيّما المصنفين كإرهابيين في سورية)، وهو يمثل أحد أعقد الملفات المشتركة بين التحالف ودمشق، إذ يتطلب مقاربة متوازنة بين مقتضيات العدالة والمساءلة ومتطلبات الأمن الوطني، في ظل غياب توافق دولي حول آليات المحاكمة أو الإعادة.
خامسًا: مواقف الأطراف الرئيسة من انضمام سورية للتحالف
من منظور الأطراف الرئيسة في التحالف الدولي، يُعَدّ انضمام سورية اختبارًا سياسيًا واستراتيجيًا لتوازن المصالح داخل منظومة الأمن الجماعي، إذ ترى الولايات المتحدة في هذا الانضمام فرصةً لإعادة هيكلة ترتيباتها الميدانية والسياسية في سورية، وتحويل وجودها العسكري من إدارة حرب بالوكالة، إلى شراكة رسمية مع دولة ذات سيادة. فعلى الصعيد العملياتي، يُتيح هذا التطور إنشاء قناة تنسيق مؤسسية مباشرة بين قوات التحالف والجيش السوري الجديد، ما يعزز من كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية، ودقة العمليات ضد خلايا التنظيم المتبقية. وعلى المستوى السياسي، يوفّر هذا التعاون إطارًا جديدًا للشرعية الميدانية داخل سورية، إذ يتحوّل الوجود الغربي من حالة تدخل موصوفة بانتهاك السيادة، إلى علاقة شراكة قائمة على التنسيق الرسمي، الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع نطاق الشرعية القانونية للتحالف، ويخفف حدة الانتقادات السابقة. في هذا السياق، تسعى واشنطن إلى استثمار الانضمام لتعزيز الدعم العسكري والاستخباراتي للحكومة الجديدة، بالتوازي مع سياسة تدريجية لرفع العقوبات، مقابل مؤشرات إصلاح مؤسسي، بما يحقق مواءمة بين الأمن والاستقرار السياسي.
وتنظر دول الاتحاد الأوروبي، إلى الشراكة مع سورية، بوصفها وسيلة لترجمة التزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب، مما يسهل عليها الانخراط في مشاريع الإعمار والتنمية داخل سورية، وستستفيد من وجود حكومة شريكة يمكن التنسيق معها في ملفات حساسة، مثل إعادة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم، ما يعزز التعاون الأمني، ويحدّ من المخاطر العابرة للحدود، وبالمجمل، سيمثل انضمام سورية إلى التحالف بالنسبة للغرب انتقالًا من مرحلة الحرب إلى مرحلة بناء السلام في هذا البلد.
وبالنسبة إلى تركيا، يُنظر إلى انضمام سورية للتحالف بوصفه فرصة استراتيجية مزدوجة؛إذ يمكّن دمشق من تحمّل المسؤولية الأمنية عن ملف “قسد”، ويحدّ من التهديدات على حدودها الجنوبية، ويُتيح لأنقرة إعادة تعريف علاقتها بالتحالف الدولي عبر بوابة التعاون الأمني الإقليمي. ولذلك رحّبت تركيا مبدئيًا بهذه الخطوة، لكنها اشترطت أن تكون مصحوبة بإنهاء الدعم العسكري واللوجستي الأميركي لـ “قسد”، وإعادة المناطق الحدودية إلى سلطة الدولة السورية. وترى تركيا أن استمرار التحالف في التعاون مع “قسد” لم يعد مبررًا، بل قد يُقوّض جهود إعادة توحيد سورية، وقد تعرض تركيا دعمًا مباشرًا في إدارة مراكز احتجاز مقاتلي “داعش” والمناطق الحدودية، بشرط ضمان أمنها القومي. وكانت تركيا والأردن والعراق وسورية قد اتفقت على تشكيل تحالف رباعي للتعاون المشترك ضد تنظيم “داعش”، وتشكيل آلية للتحرك والتعاون والتنسيق ودعم الحكومة السورية، ونزع الذريعة الأميركية لدعم “قسد”[18]. وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية التي قد تعدّ هذه الخطوة بوابة لفتح المجال أمام شراكات أمنية أوسع، شرط أن تُدار ضمن رؤية سورية وطنية متوازنة تحافظ على توازن العلاقات مع حلفائها الإقليميين.
في المقابل، يُتوقّع أن تتعامل روسيا وإيران مع الخطوة بحذر، فكلتاهما كانت الحليف العسكري الأبرز للنظام السابق، وترى في الوجود الغربي المتجدد تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية، وقد تخشى روسيا أن يؤدي انخراط دمشق في التحالف الدولي إلى تقليص نفوذها العسكري والسياسي في سورية، ومع ذلك، من المرجح أن تتعامل روسيا ببراغماتية، فتبدي دعمًا لمحاربة الإرهاب، ولا سيما أنها دخلت في مرحلة ترتيب العلاقات من جديد مع سورية. أما إيران فإنها ترى في هذا الانضمام محاولة أميركية لإقصائها نهائيًا عن المشهد السوري، وستسعى إلى ضمان مصالحها عبر قنوات خلفية ودبلوماسية هادئة.
إذًا في حال انضمام سورية للتحالف، من المرجّح تكثيف العمليات المشتركة ضد بقايا “داعش”، مع اتفاقيات تفصيلية للتعاون العسكري والأمني وتبادل للمعلومات، ويُتوقّع حدوث تحسّن تدريجي في المناطق المعرّضة لهجمات متفرقة مع اتساع نطاق التنسيق بين سورية والشركاء الدوليين، وسيمنح الانضمام دفعةً لمسار إعادة إدماج سورية دوليًا، عبر فتح قنواتٍ دبلوماسية أوسع. في المقابل، تبقى هناك اختبارات صعبة محتملة، منها محاولات انتقامية من “داعش”، وتوقعات شعبية سريعة النتائج قد تولّد تململًا، إذا تأخر التحسّن المعيشي والأمني، وستحتاج الإدارة السورية إلى موازنة المكاسب العاجلة مع إدارة التوقعات وإظهار خطوات رمزية تؤكد السيادة مع استمرار الشراكة، ويُتوقع انكفاء “داعش” إلى جيوب معزولة غير قادرة على تهديد الاستقرار، والتوجّه نحو إغلاق ملف المخيّمات، عبر برامج تأهيل وإدماجٍ بإسناد أممي، ومع تحسّن الوضع الأمني، يُتوقّع تنشيط مسار إعادة الإعمار واستقطاب الدعم الدولي والإقليمي، ما يدعم مسار بناء المؤسسات وترسيخ الشرعية عبر استحقاقات سياسية منظَّمة، وإقليميًا قد تتجه القوى الفاعلة إلى ترتيباتٍ جديدة، تقلّل الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي مباشر، مع تقوية مؤسسات الدولة وزيادة قدرتها على الضبط، شرط نجاح تفاهمات متوازنة مع الأطراف المؤثرة، وحدوث تقدم ملموس في دمج القوى المحلية ضمن بنية الدولة.
سادسًا: الخاتمة
شكّل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، منذ تأسيسه عام 2014، عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مسار الأحداث في سورية والمنطقة بأسرها، إذ استطاع أن يحقق هدفه الأبرز المتمثل في إسقاط ما كان يُعرف بـ “دولة داعش”، وتفكيك بنيتها التنظيمية، ونتج عن ذلك إنجازات ملموسة، وانحسار مستوى التهديدات الإرهابية العابرة للحدود على الصعيدين الإقليمي والدولي. إلا أن هذا الانتصار جاء بكلفة بشرية ومادية باهظة؛ فالحرب خلّفت وراءها مدنًا مدمّرة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة، ومجتمعات ممزّقة تستدعي مصالحة وطنية عميقة لإعادة لحمتها، إضافة إلى آلاف الضحايا، وعشرات الآلاف من المهجّرين الذين ما زالوا خارج بيوتهم منذ عشر سنين. وقد أفرزت هذه المرحلة تحديات جديدة لا تقلّ خطورة، أبرزها مصير المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، واستمرار التوتر بين القوى المحلية، فضلًا عن خطر الخلايا النائمة التي ما زالت تحاول استعادة نشاطها في البادية والمناطق النائية.
وعلى الرغم من ذلك، تظل تجربة التحالف الدولي في سورية علامة مهمّة، في تاريخ العمل الجماعي الدولي ضد الإرهاب، إذ مثّلت نموذجًا لتكاتف عالمي نجح في مهمته العسكرية، لكنه ترك وراءه واقعًا جيوسياسيًا معقدًا، يتطلب رؤية دبلوماسية طويلة الأمد لإرساء سلام حقيقي، وإذا ما أُتبعت هذه النجاحات العسكرية بسياسات حكيمة لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات، فقد تكون تجربة التحالف نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، لا في سورية فحسب، بل في كامل الإقليم. ومع هذه الأحداث، تجد الحكومة السورية نفسها أمام معادلة دقيقة، فهي تسعى إلى استثمار عضويتها المحتملة في التحالف، كوسيلة لاستعادة شرعيتها الدولية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكنها تخشى أن يتحوّل التعاون الأمني إلى مدخل لتقليص استقلال قرارها السيادي، أو لفرض أجندات سياسية خارجية عليها.
ويتطلب نجاح انخراط سورية في التحالف الدولي مقاربةً متدرجةً، تحفظ السيادة وتضمن الاعتراف الدولي في آن واحد، حيث تكمن الأولوية في تفعيل تعاون أمني واستخباراتي منضبط، ضمن إطار وطني مؤسسي يخضع لرقابة مدنية ويمنع التبعية الخارجية، بالتوازي مع صياغة سياسة دبلوماسية متوازنة توضّح أولويات التعاون مع الشركاء الغربيين والعرب. وتنبغي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، لبناء شراكات أمنية تعزز القدرات المحلية بدل استبدالها، وربط المسار الأمني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان استقرار مستدام، إذ أثبتت التجربة أن النصر العسكري لا يكفي من دون مؤسسات قوية واقتصاد متعافٍ. وسيكون انضمام سورية إلى التحالف، إن تحقق، خطوةً تأسيسيةً لإعادة تموضعها في النظام الدولي، وفرصة لبناء نموذج جديد من الشراكة المتوازنة، بين السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن الجماعي والتنمية.
[1] UN Security Council Resolution 2249 (2015), United Nations Security Council, issued 20 November 2015, https://shorturl.at/MypBi
[2] موقع التحالف الدولي GLOBAL COALITION، الرابط: https://theglobalcoalition.org/ar/
[3] إيان مكاري، تنظيم الدولة الإسلامية بعد خمس سنوات: التهديدات المستمرة والخيارات الأمريكية، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 21 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/493jcqO
[4] “الخارجية الروسية”: الوجود الأمريكي في سوريا “غير قانوني” وعامل في زعزعة الاستقرار، شبكة شام، 27 كانون الثاني/ يناير 2024، شوهد في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/49DG5RO
[5] موقع وزارة الخارجية الفرنسية، الرابط: https://bit.ly/4owcXAU
[6] Claire Mills, ISIS/Daesh: the military response in Iraq and Syria, House of Commons Library, 08 March, 2017, Link https://bit.ly/4onK75x
[7] إيان مكاري، تنظيم الدولة الإسلامية بعد خمس سنوات: التهديدات المستمرة والخيارات الأمريكية، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 21 آذار/ مارس 2024، الرابط: https://bit.ly/493jcqO
[8] Amnesty International. (2019, April 25). Syria: Unprecedented investigation reveals US-led Coalition killed more than 1,600 civilians in Raqqa ‘death trap’, link https://bit.ly/4oTMgWy
[9] Airwars. (n.d.). U.S.-led Coalition in Iraq & Syria: estimate of civilian deaths, link https://bit.ly/43gDCci
[10] أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تنشر بيانًا مشتركا حول التطورات في سوريا، ريباز نيوز، 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الرابط: https://bit.ly/4qIVLcK
[11] مشروع الذاكرة السورية – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 25 كانون الثاني/ يناير 2025، بيان أمريكي-بريطاني-فرنسي-ألماني مشترك بشأن الحلّ السياسي في سورية، وثيقة، الرابط https://bit.ly/47ppEHx
[12] المجموعة المصغرة من أجل سورية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية، العربي الجديد، 27 أيلول/ سبتمبر 2019، شوهد في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/43PzdNz
[13] Borger, J. (2017, June 18). US plane shoots down Syrian aircraft that attacked US-backed forces, The Guardian, link https://bit.ly/3XbGmnD
[14] 65هجومًا.. تصاعد الهجمات الإيرانية على قواعد التحالف الدولي في سوريا، موقع +963، 27 تموز/ يوليو 2024، شوهد في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/486uWqD
[15] براك: الشرع سيزور واشنطن الشهر الجاري، الجزيرة، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، شوهد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/49AH84Y
[16] Will Syria join the Global Coalition to Defeat ISIS?”, Middle East Institute, published on 27 October 2025, https://tinyurl.com/4djzuyvp
[17] Samer al-Ahmed, Subhi Franjieh, Will Syria join the Global Coalition to Defeat ISIS?, Middle East Institute, 27 October 2025. Link https://bit.ly/43Al0nR
[18] تركيا اتفقت مع الأردن والعراق وسوريا على «تحالف رباعي» ضد «داعش»، الشرق الأوسط، 16 شباط/ فبراير 2025، الرابط: https://bit.ly/48YvBfL
- المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة