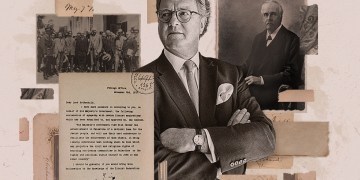“لا يزال حلم رجال الدولة والعسكريين الذين يتصورون أنهم يستطيعون إيجاد المُتَّحَد في مجتمعاتهم، من دون الخوض في غمار السياسة. لكن الناس يمانعون الاستسلام لصورة الانسجام الاجتماعي من دون نشاط سياسي”. تلك الكلمات الواردة في كتاب “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة”، للأكاديمي الأميركي الراحل، صموئيل هنتنغتون، قد تكون مفتاحاً لفهم ما عشناه في سوريا، خلال الـ 13 عاماً الأخيرة بعد الثورة ضد نظام المخلوع بشار الأسد. وما نعيشه اليوم أيضاً، وما قد نعيشه في المدى الزمني القريب.
يرفض كثير من المطلعين بشكل كبير على الأدبيات الكلاسيكية في علم السياسة، الاستشهاد بأفكار هنتنغتون، المعروف بنظرية “صدام الحضارات” في تسعينات القرن الماضي. ليس فقط، بسبب نظريته تلك المثيرة للجدل، والتي اعتبرها البعض أنها تستهدف تحقيق المصالح الغربية وتأكيد الهيمنة الأميركية. بل لأسباب أبعد ذلك. فالأستاذ بجامعة هارفرد لأكثر من خمسين عاماً، عُرف برهاناته الواقعية المحافظة، وبتقديم معيار الاستقرار وديمومة نظام الحكم، أكثر ربما، من معيار الديمقراطية، في معالجاته المتخصصة لأنظمة الحكم القائمة في بلدان العالم خلال عمله البحثي، منذ ستينات القرن الماضي، وحتى بداية الألفية الحالية.
ومقابل الرأي السابق، يقر متخصصون بمقاربات هنتنغتون الملفتة للغاية، بخصوص العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية، وتحليل عمليات إرساء الديمقراطية، والتطور السياسي للأنظمة الحاكمة. ومن أبرز مساهماته في هذا المجال، كتابه الصادر عام 1969، والمعنوّن بـ “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة”. ومن بين سطور هذا الكتاب، تحديداً في جزئه الأول حيث تتركز الأفكار والتصورات الأساسية التي نظّر لها هنتنغتون، نجد إسقاطات مفيدة للغاية في مقاربة المشهد الراهن اليوم، في سوريا.
من أبرز تلك الإسقاطات، إشارته إلى أن “أبسط نظام سياسي هو ذلك الذي يعتمد على شخص واحد، وهو في الوقت نفسه، الأقل استقراراً”. وإشارته الأخرى إلى أن “السياسي الذي يحاول مضاعفة السلطة أو غيرها من القيم على المدى القريب غالباً ما يضعف مؤسسته على المدى الطويل”. الإشارة الأخيرة تلك، يمكن لحظها بشكل خاص في تجربة حكم حافظ الأسد، الذي راهن على مضاعفة السلطة المركّزة في قبضته، حتى أورث لابنه نظاماً قصير الأمد مؤسساتياً. ليأتي ابنه، ويضيف إلى هوس أبيه باحتكار السلطة، هوساً باحتكار الثروة، التي عمل على تركيزها في قبضة المحسوبين عليه، منذ وصوله إلى الحكم. النتيجة كانت انحلالاً مؤسساتياً، رأينا كيف انعكس انهياراً صادماً في أيام معدودة، لنظامٍ ظُنَ لعقود أنه راسخ، ليُوصف بعيد سقوطه، وفي الصحافة الروسية ذاتها، بأنه كان “بيت من ورق”.
لكن، لا يكفي هوس الحاكم بمضاعفة السلطة والثروة في قبضة المحسوبين عليه، لتفسير الانهيار المؤسساتي الذي حصل مع سقوط نظام الأسد في سوريا. وهنا، يصبح الحديث بهدف تحصيل العِبرة لتجنب استنساخ ذات التجربة “الأسدية”. خاصة وأننا نحيا في لحظة تاريخية. تاريخيتها ليست متمثلة في تخلص السوريين، من لعنة حكم “آل الأسد”، فقط. بل والأهم من ذلك، أنها اللحظة التاريخية المناسبة لتجنب استنساخ هذه التجربة. وبهذا الصدد، يشير هنتنغتون إلى أن “عملية التخلص من طبقة حاكمة صغيرة ومتجانسة، مضافاً إليه تنوع القوى الاجتماعية والتفاعل المتزايد بين هذه القوى، هي شروط مسبقة لبروز التنظيمات السياسية والإجراءات ولاستحداث المؤسسات السياسية أخيراً”. وهي الحالة القائمة الآن في سوريا، بحذافيرها. فالتخلص من طبقة آل الأسد والمقربين منهم، أتبعها حراك اجتماعي وتفاعل كبير. فالسوريون وكأنهم كانوا مغيبين لعقود، في سجن، وخرجوا اليوم إلى ساحات الحرية السياسية، ليدلي كل منهم بدلوه. عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أولاً، ومن ثم إلى أرض الواقع، اعتباراً من تظاهرة ساحة الأمويين المتواضعة، أمس الخميس، رغم الجدل حول خلفية من دعا إليها، والمواقف السابقة للمنظّمين والمتكلمين فيها. هذه التظاهرات والوقفات ستتفاقم في الفترة المقبلة. وكلما حظيت بحماية وإتاحة وسلمية أكبر، كلما اقتربنا أكثر من المنعطف التاريخي الأهم، الذي يمكن له أن يقطع مع الاستبداد بكل ألوانه، ويتيح لسوريا أن تبدأ مسيرتها الطويلة والتي ستكون مرهقة من دون شك، نحو نظام سياسي يعبّر عن “مُتَحد” يمثّل السوريين.
يركّز هنتنغتون على هذا المصطلح كثيراً. ويمكن أن نفهم أن “المُتحد” الذي يقصده، هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي الذي يمثّل حلاً وسطاً يجتمع حوله أبناء مجتمع معقّد، ليشكّلوا على أساسه تجمعهم السياسي المشترك.
لكن قبل الولوج إلى خلق “متحد سياسي” يجمع السوريين، يجب محاولة تغيير النظرة المتبادلة بين مكونات مجتمعهم المعقّد. ويوضّح هنتنغتون “لا تستطيع جماعتان لا ترى الواحدة منهما في الأخرى إلا عدواً رئيسياً لها، أن تكوّنا قاعدة لمُتَحد حتى تتغير تلك النظرة المتبادلة. لا بد من وجود بعض الانسجام في المصالح بين الجماعات التي تؤلف المجتمع”.
في الحالة السورية الراهنة، ومع ما أورثته حقبة الأسد من أضرار على العيش المشترك بين مكونات هذا البلد، نحتاج بشدة لتغيير النظرة المتبادلة إلى بعضنا. وقد يكون الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الذي وصل إليه السوريون بفعل حرب النظام ضدهم لأكثر من عقد، سبباً لدفعهم إلى تفضيل المصلحة المشتركة، على المصالح الخاصة بكل مكوّن. لذا، نكرر أننا أمام لحظة تاريخية، بكل ما للكلمة من معنى. وإسقاطاً على الحيثية الأخيرة، نستشهد بهنتنغتون مجدداً، حينما يقول: “الإجماع العام والمصلحة المشتركة عاملان للمتحد السياسي، ويجب أن يكون الاجتماع مؤسساتي”.
بطبيعة الحال، يتحقق “الإجماع العام”، عبر عقد اجتماعي يمثّل صيغة وسط يمكن أن يتفق عليها كل السوريين، حول شكل الحكم والدولة ونواظمها القانونية والقيمية. والدافع على تحقيق ذلك بأسرع وقت، وبأسلم طريقة، هو “المصلحة المشتركة” بينهم، المتمثلة بحاجتهم الملحة لتأسيس حكم رشيد، ينتشل البلاد من الكارثة المعيشية التي تحيق بكل مكوناتها، دون تمييز. لاحقاً، يتم تمتين هذا “المُتَحد” بالمؤسسات.
ويمكن أن نختم بأن خلق “مُتَحد سياسي” يجمع السوريين، ويكون قاعدة لنظام سياسي مستقر ومؤسساتي، تتوضع على قمة هرمه حكومة رشيدة، لا يمكن أن يتحقق إلا بمقدار واسع من الدعم في المجتمع. ووفق هنتنغتون “إذا كانت جماعة صغيرة من الطبقة العليا هي التي تنظم فقط وتتصرف وفق مجموعة من الإجراءات، يكون هذا الدعم محدوداً. أما إذا كان قسم كبير من السكان منظماً سياسياً ويتبع الإجراءات السياسية، يصبح المقدار (مقدار الدعم) كبيراً”.
وهكذا تصبح الحاجة ملحة لتقبّل مشاركة سياسية واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري. لتكون منخرطة في مرحلة انتقالية يكون هدفها خلق هذا “المُتَحد” المعبّر عنه في دستور يمثّل كل السوريين، كحل وسط بين تطلعاتهم وأمزجتهم القيمية المتنوعة. بخلاف السير بهكذا وصفة للمستقبل، فإننا سنكون أمام تجربة حكم “أسدي” جديدة، أو فوضى غير خلّاقة، وفي أحسن أحوال، سنكون أمام نظام سياسي مُهلهل، يمكن لمؤسساته أن تنهار في لحظة رفض مجتمعي واسعة، كما انهار نظام الأسد ومؤسساته، وكأنه “بيت من ورق”.
- تلفزيون سوريا