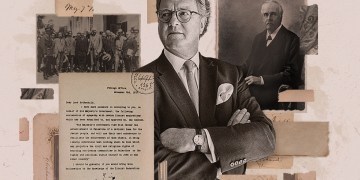إذا تأملنا المشهد السوري الراهن بعمق، نرى أمامنا معضلةً لا تختزلها حوادث العنف اليومية، فليست القضية في أخبار الخطف أو القتل ذات الطابع الطائفي أو الانتقامي التي تتكرّر في مدنٍ مختلفة، ولا في مشهد طفل يُختطف في اللاذقية أمام المارّة من دون تدخّل، أو معلّمة تُقتل في طريقها إلى عملها في حمص. ليست هذه الوقائع، على قسوتها، سوى مظاهر سطحية لأزمة أعمق تتمثّل في بنية اجتماعية – سياسية مختلّة، تُعيد إنتاج العنف وتغذّي دائرة الانتقام، مهدِّدةً أيَّ إمكانية لانتقال متوازن أو لتأسيس دولة قادرة على ضبط الفوضى.
أدّى غياب إطارٍ وطنيٍّ جامعٍ للعدالة الانتقالية، وتردّد المؤسّسات في رسم حدودٍ واضحةٍ بين المحاسبة والانتقام، إلى تفريغ مفهوم العدالة من مضمونه، وفتح المجال أمام منطق القصاصين، الفردي والجماعي، ليحلّ محلّ الدولة والقانون، فتبرز في بعض المناطق السورية حوادث تحمل طابعاً انتقامياً، يُستهدَف فيها الأبرياء لمجرّد انتماءٍ طائفيٍّ أو مناطقيٍّ، في انحرافٍ خطيرٍ عن أيّ مفهومٍ للعدالة أو المساءلة. هذا الميلُ (المتنامي) إلى تطبيع القصاص الذاتي يعكس تراجعاً واضحاً في حضور القانون والمؤسّسة، لأنّ العدالة لا يمكن أن تُمارَس إلّا ضمن إطارٍ مؤسّسيٍّ يضمن التحقيق والمحاسبة، لا عبر نزعات الغضب الجمعي أو منطق الهُويَّة المغلقة.
بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت أوروبا نفسها أمام إرثٍ ثقيلٍ من العنف العنصري والجرائم الجماعية. إذ لم يكن التحدّي الأكبر في محاكمة النازيين، إنما في إعادة دمج المجتمع الألماني في إنسانيته. لقد واجه الألمان ما سمّاه الفيلسوف كارل ياسبرز “الذنب الجمعي”، أي إدراك مسؤولية المجتمع كلّه عن خلق البيئة التي سمحت بوقوع الجريمة، حتى إن لم يشارك جميع الأفراد فيها. هذا المفهوم ساهم في تحويل الوعي الألماني من عقلية التبرير إلى ثقافة المساءلة. لم تكن العدالة آنذاك عملاً انتقامياً، بل كانت عملية إعادة تربية أخلاقية – سياسية استمرّت عقوداً، وأثمرت في النهاية ديمقراطية مستقرّة.
الأمن في المرحلة الانتقالية معيار الشرعية السياسية، وغيابه يُفقد الدولة معناها
في المقابل، في رواندا، كانت الجراح أعمق وأكثر مباشرة، فالإبادة التي وقعت عام 1994 لم تترك مجالاً لتفادي المواجهة، فاضطر المجتمع إلى تجريب العدالة من القاعدة عبر محاكم “الغاتشاكا”، وهي شكل محلّي من العدالة التصالحية. كانت هذه المحاكم تعتمد على الاعتراف والمسامحة أكثر من العقاب.
لم يكن الهدف معاقبة الجناة فحسب، بل تفكيك عقلية القبيلة التي جعلت الهوتو يرون في التوتسي “عدواً وجودياً”. بهذه التجربة، تحوّلت رواندا حالةً دراسيةً مهمةً في كيفية معالجة الجرح الجماعي عبر الذاكرة والاعتراف، وليس عبر الإلغاء أو النسيان. هاتان التجربتان، رغم اختلافهما، تلتقيان في نتيجة واحدة، فلا يمكن لأيّ مجتمعٍ أن يخرج من دوامة العنف إن لم يواجه الحقيقة وجهاً لوجه، من دون إنكارٍ أو تبريرٍ أو تديين للألم.
يُظهر غيابُ خطابٍ وطنيٍّ واضحٍ يواجه التحريض الطائفي وخطاب الكراهية في سورية خللاً في إدارة المجال العام، إذ فقدت السلطة الانتقالية دورها الرمزي في تحديد الإطار الأخلاقي للنقاش السياسي. ولم تُقدِّم مؤسسات السلطة الانتقالية (حتّى الآن) رؤيةً تواصليةً تُعيد تعريف العلاقة بين المواطنين والدولة على قاعدة الانتماء المدني لا الولاء الفئوي، ما جعل الخطاب العام يتجه تدريجياً نحو الانقسام وتكريس الهُويَّات الفرعية بوصفها بدائل للهُويَّة الوطنية.
وقد أدّى هذا الغياب إلى تآكل الإطار الرمزي الذي يُفترض أن يضبط النقاش العام، فتحوّل المجال السياسي مساحةً مفتوحةً لتبادل الاتهامات والتعبئة العاطفية، بدل أن يكون ساحةً للتفكير الجماعي وصياغة التوافقات، كما أن تفشّي السلاح المنفلت، وتكرار ما يُوصَف بالحوادث الفردية، أضعف قدرة المنظومة الأمنية والإدارية على ضبط المجال العام وإرساء الحدّ الأدنى من النظام. فالأمن في المرحلة الانتقالية مكوّن أساسٌ من مكوّنات الشرعية السياسية، ومعيارٌ لمدى قدرة السلطة على احتكار العنف المشروع وفق منطق الدولة الحديثة. لذا فإنّ استمرار هذا الفراغ الأمني يُفقد المرحلة الانتقالية في سورية معناها، لأنّ غياب سلطة قادرة على فرض القانون يعني عملياً غياب الضامن الأول لأيّ تحوّلٍ سياسي أو مؤسّسي مستقرّ.
حذّر فلاسفة الأخلاق من أمثال إيمانويل كانط من أنّ أيّ عدالةٍ تنبع من الانفعال لا من الواجب، تتحوّل حتماً ظلماً جديداً، فيما يذكّرنا جون رولز بأنّ “العدالة كإنصاف” لا يمكن أن تقوم إلّا في مجتمعٍ يقبل التعددية ويكبح نزعات الانتقام. أمّا في السياق السوري، فإنّ استمرار تحويل المظلومية خطاباً مهيمناً، يهدّد بإنشاء منظومة قيمٍ جديدة تُشرعن العنف باسم التاريخ، وتُغلق أفق العيش المشترك باسم الذاكرة. وفي هذا الإطار، تُصبح وراثة الأحقاد واحدةً من أخطر التحدّيات أمام أيّ مشروعٍ وطنيٍّ جامع في سورية. فحين تُورَّث الكراهية كما تُورَّث اللغة والانتماء، يتحوّل العنف جزءاً من الوعي الجمعي. ويمكن قراءة هذا الميل من خلال مفهوم “التنافر المعرفي” لليون فستنغر، إذ يميل الأفراد إلى تبرير أفعالهم العنيفة عبر سرديّاتٍ تمنحهم شعوراً زائفاً بالبراءة أو البطولة. وبهذا، يتكرّس العنف آليةً نفسيةً للدفاع عن الذات، لا جريمةً تحتاج إلى مساءلة. هكذا يغدو المجتمع أسيراً لدائرةٍ مغلقةٍ من المظلومية والعنف المتبادل، فتُفقد العدالة معناها ويتحوّل الانتقال إلى تكرارٍ دائمٍ للماضي. إنّ مواجهة هذه البنية تكون بإعادة تعريف العدالة نفسها فعلاً مدنيّاً جامعاً، وليس بوصفها أداةً للفرز أو الانتقام، وباعتبارها الشرط الأول لولادة عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ يعيد للإنسان قيمته قبل أن يُعيد للدولة هيبتها.
لا تتوقّف مسؤولية السلطة الانتقالية السورية عند حدود التقصير في تفعيل مسار العدالة الانتقالية، بل تتجلّى أيضاً في عجزها عن بناء منظومةٍ قانونيةٍ متماسكة تُعيد تعريف العدالة قيمةً جامعةً. لقد أتاح غياب هذا الإطار الواضح بروز أنماطٍ من “العدالة الانتقائية” تمارسها جماعاتٌ محلّية على نحوٍ يعمّق الشرخ الوطني ويُفقد القانون معناه مظلّةً مشتركةً لجميع المواطنين. بهذا المعنى، لم تَعُد المشكلة في غياب العدالة فحسب، بل في تحوّلها ممارسةً متعدّدة المراكز خارج المؤسّسة، ما يضعف ثقة المجتمع بفكرة الدولة نفسها، كما لا يمكن فهم هذا الخلل إلا انعكاساً لغياب الوعي بطبيعة المرحلة الانتقالية ذاتها. فنجاح أيّ انتقالٍ يقاس بقدرة النظام السياسي الجديد على تجاوز أنماط السلطة السابقة في التفكير والممارسة، وعلى كسر الحلقة التي تربط العنف بالشرعية. لذا فإنّ تجاهل هذا البعد البنيوي يجعل الانتقال السوري هشّاً في عمقه، قابلاً لإعادة إنتاج انقساماته تحت شعاراتٍ مختلفة.
أمّا الخطر الأعمق فيكمن في تحوّل المظلومية إلى رأسمالٍ رمزيٍّ وسياسيٍّ بيد قوى ما دون الدولة، تُستثمَر في الخطاب العام لتبرير العنف واستدامة الكراهية. وفي ضوء ما يقدّمه بيير بورديو من تحليلٍ لرأس المال الرمزي، يمكن القول إنّ سرديّات الألم والهزيمة تحوّلت أدواتٍ لتثبيت امتيازاتٍ جديدة، يُعاد من خلالها إنتاج السلطة الاجتماعية على أساس الانتماء لا المواطنة. وهكذا، تتكرّس في المجال العام بنيةٌ ثقافيةٌ ترى في الانتقام وسيلةً للعدالة، وفي الكراهية شكلاً من الانتماء. هنا تغيب فكرة القانون بوصفه المرجع الأخير، ليحلّ محلّه منطق الغضب الجماعي.
تظهر المظلوميّة في المجتمعات الخارجة من الحرب أو الانهيار السياسي أحدَ أخطر أشكال الوعي الجمعي المشحون بالعاطفة، فهي تبدأ تجربةَ ألم حقيقيةً ثمّ تتحوّل، حين لا تُفكّك معرفياً، هوساً جماعياً يغذّي الكراهية ويبرّر العنف، ويكمن الخطر في تحوّله هُويَّةً مغلقةً، تبني وجودها على الماضي وتستمدّ شرعيتها من معاناة لم تُعالَج بعد. هذا النمط من الوعي الجمعي يجعل المجتمع أسير دور الضحية، غير قادر على التحوّل فاعلاً في بناء المستقبل. بينما يُفسّر علم النفس الاجتماعي هذه الظاهرة بوصفها انتقالاً من الألم الفردي إلى حالة انصهار في “اللاوعي الجمعي”، فتفقد الجماعة قدرتها على التمييز بين الذاكرة والتعبئة.
تُستثمَر المظلومية سياسياً تفقد بعدها الأخلاقي، وتتحوّل وسيلةً للهيمنة وتبرير العنف
ويصف غوستاف لوبون الجماهير في هذه الحالات بأنها تنفصل عن المنطق وتتحرّك بدوافع وجدانية مشتركة. وتوضّح أبحاث سيغموند فرويد أن هذا الانصهار يولّد “تحويلاً عاطفياً” يجعل الكراهية أداةً لتماسك الجماعة داخلياً. أمّا رينيه جيرار، فاعتبر أن المجتمع المأزوم يبحث دائماً عن “مذنب” يعيد من خلال معاقبته بناء توازنه الداخلي، حتى لو لم يكن المذنب حقيقياً. وبهذا المعنى، يصبح الهوس الجماعي بالمظلوميّة آليةَ دفاعٍ جماعيةً تنقلب إلى حالة مرضية حين تُستخدم لتبرير استمرار الانقسام والعنف. أمّا حين تتحول المظلومية خطاباً سياسياً، فإنها تفقد بعدها الأخلاقي، وتتحوّل وسيلةً للهيمنة.
تاريخياً، استخدمت حركات سياسية ودينية عديدة فكرة الضحية لتثبيت شرعيتها أو توسيع نفوذها. وهنا يرى أنطونيو غرامشي أن الهيمنة الثقافية تُبنى من خلال تحويل الألم الجماعي سرديةً تبرّر استمرار السيطرة. في حين أن المجتمع الذي يظلّ سجيناً لصور مظلوميّته يفقد القدرة على إنتاج قيم المواطنة والمحاسبة. عندها يتحوّل التاريخ إلى حقل مفتوح للثأر، والعدالة إلى وسيلة انتقام. التجاوز لا يعني النسيان، وإنما القدرة على إعادة بناء العلاقة بين الذاكرة والوعي. فكما يقول عالم الاجتماع موريس هالبفاكس، فإنّ الذاكرة لا تُشفى إلّا حين تصبح جماعية بالمعنى الوطني، لا الطائفي.
ولعلّ أخطر ما يمكن أن تواجهه سورية اليوم هذا النوع من الوعي الذي يعيش على تغذية الكراهية بوصفها بديلاً من العدالة. فكل مجتمعٍ يقدّس مظلوميّته من دون أن يسائلها، يهيّئ لولادة جولة جديدة من العنف باسمها.
- العربي الجديد