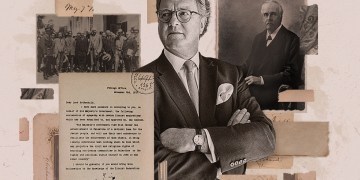لم تكن مسألة الشرعية في سوريا يوماً مسألة شكلية أو محصورة بإطار قانوني أو دستوري، بقدر ما كانت على الدوام سؤالاً مركّباً يتصل بمصدر السلطة وحقّ ممارستها، وبمن يُمثّل من، ولأي جماعة سياسية أو رمزية تُمنح شرعية الحكم، وفي ظل أي منظومة قيم تُمارس السيادة.
ولو شئنا تفكيك هذا المسار فإن البنية العميقة للشرعية السورية، منذ خمسينيات القرن العشرين، تظهر وكأنها تدور في حلقة مغلقة، فمن جهة هي لم تتجاوز الشرعية كونها امتداداً لولاءات أولية طائفية أو فئوية أو مناطقية، ومن جهة أخرى ظلّ مفهوم المواطن بوصفه فرداً سياسياً متساوياً خارج المعادلة، باعتبار أن الدولة لم تتشكل تاريخياً كجماعة قانونية بل كأداة قسر سياسي لصالح من يملك أدوات السيطرة العنيفة أو الرمزية.
إذا عدنا إلى سنوات الاستقلال الأولى، فسنجد أن النخب السياسية التي تولّت الحكم بعد خروج الاستعمار كانت تدير دولة شديدة الهشاشة، تحكم مجتمعاً لا تزال بنيته الأساسية محكومة بشبكات من الولاءات الأولية، حيث القبيلة والطائفة والمنطقة لا تزال الحوامل الفعلية للتماسك الاجتماعي، في حين كانت مؤسسات الدولة المركزية محدودة الفاعلية أو الغياب، وغير قادرة على احتكار العنف المشروع أو فرض الشرعية الحديثة التي تفترض دولة محايدة تحكم باسم القانون العام.
ما حدث فعلياً هو أن هذه الدولة الوليدة جرى اختراقها من الداخل، وجرى تسخير مؤسساتها لصالح قوى تسعى إلى تثبيت شرعيتها السياسية عبر اختراق البنية الاجتماعية وليس عبر إصلاحها، فتحولت الدولة إلى أداة توظيف سلطوي للانتماءات ما قبل السياسية، بدل أن تعمل على تجاوزها وإدماجها ضمن عقد وطني جامع.
تحوّلت منظومة الشرعية إلى ما يشبه إعادة هندسة شاملة لفكرة الدولة نفسها، بحيث لم يعد مطلوباً فقط تطويع المجتمع أو ضبط مؤسساته، ولكن إعادة تعريف مفهوم الانتماء ذاته.
الانقلابات العسكرية التي توالت بعد عام 1949 لم تكن فقط تفكيكاً للمسار الدستوري البرلماني، إذ كانت تأسيساً لمرحلة جديدة من إنتاج السلطة، تنزع إلى بناء شرعية بديلة لا تستند إلى التصويت أو العقد الاجتماعي، وإنما إلى مفهوم “الخلاص الثوري” الذي يقوم على شخصية الزعيم أو المؤسسة العسكرية بوصفها تجسيداً لإرادة تاريخية عليا. ومع كل انقلاب جديد، كانت الدولة تبتعد أكثر عن فكرة الشرعية القانونية العقلانية كما صاغها ماكس فيبر، وتستقر تدريجياً في شرعية كاريزمية أو أمنية تتغذى من خارج المؤسسات، وتُعيد إنتاج نفسها من خلال التجييش لا من خلال التمثيل، ومن خلال الولاء لا من خلال المشاركة.
وكانت الطائفية، في هذا السياق، تعود إلى الواجهة بوصفها رافعة غير معلنة لهذا الشكل من الشرعية، إذ أُعيد تشكيل الجيش والمؤسسات الأمنية على نحو غير متوازن، جعل من الانتماء الطائفي عاملاً حاسماً في بنية القوة، وإن لم يُصرّح به علناً، فالثقل الطائفي ظل يعمل كشبكة حماية ضمنية للنظام السياسي، دون أن يكون مفهوماً واضحاً في خطاب الدولة الرسمي، الأمر الذي خلق تناقضاً بنيوياً بين الخطاب القومي أو الوحدوي من جهة، والطابع الفعلي للسلطة من جهة أخرى.
ومع استقرار الحكم تحت سلطة حافظ الأسد، تحوّلت منظومة الشرعية إلى ما يشبه إعادة هندسة شاملة لفكرة الدولة نفسها، بحيث لم يعد مطلوباً فقط تطويع المجتمع أو ضبط مؤسساته، ولكن إعادة تعريف مفهوم الانتماء ذاته. لم تعد الدولة حيادية ولا مفترضة كإطار قانوني يتساوى فيه الجميع، بل باتت مملوكة رمزياً وفعلياً لنظام البعث، الذي قدّم نفسه كضامن للوحدة والاستقرار، مقابل أن يتنازل المواطن عن حقه في المساءلة أو المشاركة، أو حتى في التفكير خارج المنظومة.
في ظل هذا النمط من الشرعية، لم تعد الطائفة مجرد مكوّن اجتماعي، فقد أصبحت بنية حماية سياسية، في حين تراجعت المواطنة إلى موقع رمزي لا فاعلية له، فهي تُذكر في الدستور فقط، لكن مفاعيلها الفعلية معلّقة.
إن التحوّل من الطائفة إلى المواطن لا يتحقق بالإرادة السياسية وحدها، ولكن بانقلابٍ في مفهوم الشرعية نفسه
وعندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، لم تكن فقط انفجاراً اجتماعياً أو احتجاجاً سياسياً، لكنها كانت في جوهرها محاولة لاستعادة الشرعية من مصادرها الأصلية، أي من الإرادة الجمعية ومن الحقّ الطبيعي للمواطن في المشاركة والمحاسبة. رفعت الثورة شعار “الشعب السوري واحد” كإعلان رفض للطائفية، إلا أن هذا الشعار اصطدم بواقع اجتماعي شديد التشظي، لا تزال بنياته مأسورة للانتماءات الأولية، ولا تملك مؤسسات جامعة ولا تقاليد ديمقراطية متجذّرة.
الأكثر تعقيداً أن لحظة انهيار الشرعية الرسمية لم تُفضِ إلى بناء شرعية قانونية جديدة، إنما أعادت فتح الحقل السياسي لصراع مفتوح على التمثيل، حيث ظهرت شرعيات موازية أو متنازعة، تتغذى من الدين أو السلاح أو الخارج، من دون أن تُنتج مفهوماً جامعاً للمواطنة.
وبدل أن يتم الانتقال إلى شرعية عقلانية حديثة، وجدت سوريا نفسها خلال السنوات الماضية أمام فراغ سيادي يملؤه المتنازعون، لكن من دون عقد اجتماعي، ومن دون حوار حقيقي حول ما تعنيه المواطنة بوصفها أساس الانتماء السياسي.
ربما كانت المعضلة الأكثر عمقاً في المشهد السوري ليست فقط في انهيار النظام القديم، إذ تجلت في عجز قوى التغيير عن تأسيس مفهوم جديد للشرعية، يُخرج العلاقة بين المواطن والدولة من منطق الحماية والانتماء المغلق، إلى منطق التعاقد الطوعي والتمثيل المتكافئ. الشرعية، في معناها الحديث، لا تُبنى فقط بنصوص دستورية، ولا بصناديق اقتراعٍ في فراغ، إنما بمنظومة ثقافية ومؤسساتية تعترف بالمواطن كفاعل سياسي مستقل، وتُؤسس الدولة كإطارٍ محايد لا كأداة تحكّم.
إن الخروج من أسر الطائفة لا يعني محوها، وإنما ردّها إلى موقعها الطبيعي ضمن المجال الثقافي والاجتماعي، وتحرير السياسة من أسر الهوية المغلقة، بحيث تصبح المواطنة رابطة حية بين الإنسان والكلّ العام، تقوم على الحقوق وعلى المشاركة. وهذا يستدعي من النخب السياسية والثقافية أن تُعيد تعريف مشروعها الوطني على قاعدة كيف نبني دولة لا تحتاج إلى حماية طائفة، ولا إلى زعيم، بل إلى مواطنين أحرار ومؤسسات عادلة.
في النهاية، فإن التحوّل من الطائفة إلى المواطن لا يتحقق بالإرادة السياسية وحدها، ولكن بانقلابٍ في مفهوم الشرعية نفسه، من كونها امتيازًا يُحتكر، إلى كونها تفويض يُنتزع، ومن كونها ولاء يُمنح، إلى كونها عقد يُصاغ ويُراجع ويُحتكم إليه. هذا وحده ما يمنح الدولة شكلها العادل، وما يمنح السوريين، في نهاية هذا المسار الطويل، المعنى الفعلي لأن يكونوا شعباً لا رعايا، ومواطنين لا جماعات مرتهنة لذاكرة الانقسام أو الطوائف والعصبيات.
- تلفزيون سوريا