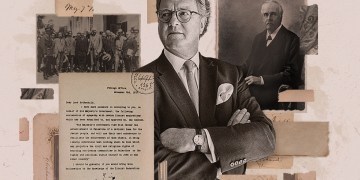من دون اعتقاد الفرد، والجماعات في مجتمع متعدد، بأن من الممكن المراهنة على وجود درجةٍ من الأمانة والنزاهة والصدق في استجابات الآخرين، يستحيل التبادل والتعاون المادي والعاطفي بين الأفراد، وتنعدم العلاقات الاجتماعية، ويحل محل المجتمع المدني مجتمع الغاب، حيث يسود قانون الأنانية المطلقة وحرب الجميع ضد الجميع.
والتسليم بإمكانية إقامة علاقات مُخلصة مع الآخر تخلو من الغش أو الخداع أو الإهانة هو ما نسمّيه الثقة العمومية. وهي علاقة أساسية سابقة على حكم القانون السياسي ووجود الدولة ذاتها وشرط لصلاحهما أيضا. وبناء هذه الثقة والمشاعر الإيجابية بين الأفراد هو من أبرز غايات الدين والأخلاق والفلسفة. وهذه الثقة والمشاعر الإيجابية المرتبطة بها هي التي تشجّع على التواصل مع الآخر وبناء علاقات مثمرة معه، أي هي التي تصنع الألفة الاجتماعية، وتحدّ من سيطرة مشاعر الخوف وسوء الظن والريبة والعداء التي تعطّل التواصل مع الآخر، وهي التي تغذّي القيم الإنسانية، كالصدق والأمانة والعدل والإحسان والعفو وضبط النفس … إلخ. وهذا ما يميز المجتمعات المدنية عن المجتمعات الطبيعية. فالثقة العمومية رأسمال معنوي مشترك لدى المجتمعات ينطوي على وعود ضمنية متبادلة: وعد بالأمان، وعد بالحماية، وعد بالعدالة، وعد بالتضامن والتكافل، ووعد بالمعنى. وحين يخون الفرد وعد الأمان، والمجتمع وعد التضامن، والمثقف وعد الصدق، والمربي وعد الأمانة، تنهار هذه الثقة، ولا يبقى لدى المجتمع أي رصيد للتفاعل الإيجابي، ويحل الخوف من الآخر والتنابذ محل التعاطف، والإرادة الشريرة محل حب الخير، فيتمزق النسيج الاجتماعي، ويحل العنف والغش والتآمر محل الأخلاق الحميدة في تنظيم العلاقات الاجتماعية.
من هنا، ليست الثقة مسألة عاطفية، بل بنية سياسية وأخلاقية تربط بين الأفراد، ولا تقوم من دونها مؤسّسات، ولا يستقيم أي نشاط اجتماعي. وهي عقد أخلاقي عمومي سابق على العقد السياسي والعقد الاجتماعي المؤسس للدولة. فلا يمكن لعقد ان يقوم بين طرفين أو أكثر من دون اعتقاد الأطراف بوجود حد أدنى من الثقة بينها، وباستعداد الآخر للوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقه. وحتى الحكومات نفسها، لا تكتسب شرعيتها إلا من ثقة مواطنيها بقدرتها على حماية حقوقهم، والقيام بالتزاماتها إزاءهم.
لم تخرج المجتمعات السورية والعربية من القرون الماضية بإرث كبير من الثقة العمومية
تعزّز الثقة الشعور بالأمان، وتشجّع على التعاون والتكافل وإقامة الشراكات، وتجنّب المجتمعات الكثير من النزاعات، أو حلها بالطرق السلمية. لذلك، يشكل رأس مال الثقة الاجتماعي عاملاً أساسياً في التقدم الاقتصادي والسياسي. فحين لا يثق المواطن في مؤسسات الدولة، يلتفّ على قوانينها بكل الوسائل. وحين يخشى الفرد نظيره، يستحيل قيام جماعة مدنية.
ففي ما وراء العقد الاجتماعي السياسي يقف ما ينبغي أن نسميه العقد الأخلاقي الذي يشكل الإطار الأعمق لتنظيم حياة البشر، بطريقة أكثر مرونة وحيوية من القانون السياسي. وعندما تغيب الثقة الاجتماعية تحل حرب الجميع ضد الجميع وتبرز الحاجة لقوة خارجية تفرض النظام والالتزام بالقهر وبالقوة. وعندما لا يرى كل فاعل في الآخر إلا عدوا، وليس شريكا، تتحول السياسة، كما هو حالنا اليوم، إلى إدارة العداء وما يستدعيه ذلك من تسويد صفحة الآخر الخصم وتضخيم عيوبه وتبرئة النفس من أي مسؤولية.
وبالمثل، عندما تنهار الثقة العمومية المؤسّسة للمجتمع المدني لا يبقى أمام الأفراد ما يعوّلون عليه لضمان مصالحهم الخاصة سوى علاقاتهم الأفقية، العائلية والقبلية والطائفية والإثنية، حيث يعثرون على الحد الأدنى من الحماية والتضامن ويقدمون هذه الانتماءات على الانتماءات السياسية للدولة والأحزاب والإدارة المدنية.
وجفاف نبع الثقة وإرادة الخير العام هو السبب في تخلف مؤسساتنا الاجتماعية، المدنية والسياسية، واعتماد المسؤولين على أنسبائهم من إخوة وأبناء في إدارة شؤون مؤسساتهم من أعلى هرم السلطة حتى المؤسسات والشركات التجارية والصناعية التي تكاد تكون في أغلبيتها الساحقة شركات عائلية. وهذا ما ينطبق أيضا على الجمعيات والأحزاب والتشكيلات المدنية المختلفة، حيث يحتكر مواقع القرار والنفوذ فيها أبناء الأسرة أو العائلة أو العشيرة، ويخلف فيها الابن أباه والأخ أخاه. فعندما ينخفض رصيد الثقة العامة لا يبقى ملاذ لبناء علاقات التعاون الإيجابي إلا علاقات القربى الدموية أو الروحية.
وربما نعثر هنا على أحد أهم العوامل التي تفسّر عجزنا، نحن السوريين، عن بناء قوى ومنظمات مدنية وسياسية فاعلة ومستقلة، وإلى حد كبير إفلاسنا السياسي، وتسليمنا في معظم الأحيان بحتمية الرهان على القوى الخارجية لحل نزاعاتنا وتنظيم شؤوننا الداخلية. وهذا ما يفسر أيضا قبولنا بتحقير بعضنا بعضاً وتقسيم أنفسنا بين “مطبلين” و”فلول” لا بين مواطنين يشكل الاختلاف في الرأي بينهم حالة طبيعية، وهو ما جعل من الإهانة المتبادلة عملة وطنية بامتياز.
جذور الخوف والشك والكراهية
لا توجد الثقة جاهزة في المجتمعات، وإنما هي ثمرة تراكم تاريخي عملت عليه التجربة الطويلة والمعاناة. وتنميتها هي من الغايات الرئيسية للأديان والفلسفات والقصص والسير والأساطير المتداولة في جميع الثقافات الإنسانية. وعلى العموم، لم تخرج المجتمعات السورية والعربية من القرون الماضية بإرث كبير من الثقة العمومية. فقد جفف الاستبداد التاريخي، وظروف الفقر والبؤس التي سادت مجتمعاتنا قروناً، ينابيع الرحمة والإحسان، ووسم العلاقات بين الأفراد بالكثير من القساوة والغلظة والأنانية، كما رسخ نزعة الانكفاء على الخصوصيات المحلية والطائفية والإثنية. ولم تساعد حكومات الانقلابات العسكرية التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال (1946) على تجاوز هذه الآثار السلبية بل عزّزتها. وجاء حكم الأسد والدولة الأمنية التي أقامها ليؤسّس لعصر الرعب والإرهاب المنظم والرقابة الشاملة، ليشكل امتحانا أخلاقيا وسياسيا للجميع، ويضاعف من تدمير الثقة على صعيد العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين السلطة الحاكمة والدولة أيضا.
سحقت الدولة الأمنية أدنى هوامش الحرية والتضامن الاجتماعي، وعطّلت مؤسّسات الوساطة والتفاعل الأساسية من أحزاب، نقابات، جمعيات، ومنتديات وإعلام مستقل، فحوّلت السوري من “كائن سياسي” أي مواطن، إلى “فرد معزول” يخاف من الدولة ومن أقرانه. صار الشكّ قاعدة التعامل، والصمت لغة النجاة، والانطواء بديلاً للتواصل.
في ظل النظام الأمني الشامل، أعيد بناء المجتمع على أسس الخوف والريبة وسوء الظن، وأصبحت الوشاية والولاء أدوات للبقاء، والكذب وسيلة للترقي، والانتهازية شرطاً للسلامة. أعيدت صياغة القيم الأخلاقية بصورة مضادة حتى يُعاقب الشريف ويُكافأ المتملّق. تحوّل الخوف إلى ثقافة عامة، واستُبدلت العلاقات الأفقية الحرة بين الأفراد بروابط عمودية قائمة على الخضوع والزبائنية والطائفية. نجح النظام في إفراغ الهوية الوطنية من مضمونها لصالح هويات جزئية، محوّلاً التنوع الديني والإثني إلى أداة للسيطرة، والإرهاب إلى سياسة، فانتفت أي ثقة ذاتية أو عامة.
وجاءت حرب الإبادة التي شنها النظام لإخماد الثورة الشعبية (2011)، بعد 40 عاما من حكم متوحش، لتقضي على المجتمع ذاته وتفتته بالعنف المادي والمعنوي معا. قوضت الدولة بمفهومها العميق وبمؤسساتها، واقتلعت السياسة من الجذور، وقسمت عموم الشعب بين قتلة مجرمين وضحايا مشرّدين، يائسين يبحثون عن مأوى. وانهار أي معنى للاجتماع والقانون والمدنية والوطنية والسياسة. خرجت جميع الأطراف مهشمة ومدمرة ماديا ومعنويا من محرقة حقيقية: لا القاتل سليم ولا الضحية. وحل محل الثقة والأمل باستعادة الكرامة والوحدة والحياة الوطنية إرث ثقيل من الصعب حمله من الأحقاد والضغائن والآلام والحسابات المعلقة، ودخل المجتمع بأكمله في عطالة كاملة واجترار الأحزان في انتظار المجهول، بينما تحولت الطبقة الحاكمة إلى عصابة مافيوية تعمل في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية.
لم تدمّر حرب الإبادة المادية والمعنوية التي شنها النظام ضد احتجاجات شعب جريح روح المجتمع والدولة فحسب، ولكنها قضت على معنى الإنسانية. وفاقم من هذا الدمار المادي والمعنوي تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته خلال أربعة عشر عاما من القتل المنظم والقصف الأعمى، وزاد من اليأس والقنوط تخبط النخب السياسية والثقافية السورية وعجزها عن التفاهم والتعاون لمواجهة المحنة الدموية.
لم تدمّر حرب الإبادة المادية والمعنوية التي شنها النظام ضد احتجاجات شعب جريح روح المجتمع والدولة فحسب، ولكنها قضت على معنى الإنسانية
لم تدمّر هذه الحرب التي دارت تحت الأرض وفوقها، في ساحات القتال وداخل الدولة والإعلام والثقافة، وعلى جسد كل سوري، الهياكل والمؤسسات المجتمعية فحسب، بل أعادت صياغة الذاكرة الاجتماعية نفسها. فقدت الكلمات معناها: “الثورة”، “الوطن”، “الحرية”، وجعلت مفردات السياسة والأخلاق والثقة مفرغة من أي مضمون. أفقدت اللغة نفسها، وهي أداة التواصل الأولى، وظيفتها واتساقها وغيرت دلالات ألفاظها. صارت الكلمات ميدانا آخر لخوض الحرب وتكريس القطيعة. وحين تُصبح اللغة ساحة حرب، لا يبقى معنى للحقيقة ولا للإنسان، تتحول الكلمات ذاتها إلى رصاص يفرض على الجميع الصمت والعزلة والخوف والاختفاء. وللأسف، لم تعثر هذه الجثة المتعفنة للحرب الإبادية على من يتبرع بدفنها وإهالة التراب عليها وتحرير السوريين من روائحها الكريهة.
أول الراغبين في استغلالها هي الحكومات والأطراف الدولية التي تريد لسورية أن تبقى ضعيفة منقسمة على نفسها ومنشغلة بنزاعاتها الطائفية والإثنية وفي مقدمها إسرائيل وبعض الأطراف والمليشيات المحلية التي تعتقد أن لها مصلحة في انهيار الدولة السورية وتقاسم أملاكها.
تشارك في هذا الموقف أيضا شخصيات فقدت مركزها مع انهيار النظام السابق وأخرى معارضة يئست من المشاركة ولا تريد للسلطة القائمة أن تنجح في تثبيت وضعها وإقامة سلطة دينية متعصبة تتناقض مع مصالحها واعتقاداتها. وهي تستغل مشاعر الخوف وانعدام الثقة الواسعة لتعبئة قطاعات من الرأي العام الخائفة لإجبار السلطة على الاعتراف بوجودها وفتح أبواب المشاركة لها. لكن الطرف الأهم هو السلطة الجديدة نفسها. فليس هناك شك في أن أطرافاً عديدة منها ومن مؤيديها لا ترى في هذا الانقسام المجتمعي وانعدام الثقة إلا فرصة أفضل لانتزاع الولاء التلقائي لأكثرية دينية جاهزة، وعزل جماعات دينية أو اجتماعية وسياسية وتهميشها. هذا ما يساعدها على تغطية المصاعب الذاتية والموضوعية الكبيرة التي تواجهها ولا تملك الإجابات الواضحة عنها. وهو ما يوفر لها أيضا قاعدة اجتماعية واسعة وموثوقة من دون أثمان باهظة تتعلق باحترام الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة وتأمين شروط العيش الكريم لشعب تتخبط أغلبيته في بحر الفقر والفاقة وانعدام الأمل بالمستقبل. من هنا التركيز على النصر وتجاهل عذابات الضحايا.
في إعادة الثقة للسوريين
كما أن انعدام الثقة ليس كارثة طبيعية، فإن استعادتها لا تحتاج معجزة، وإنما إرادة طيبة تضع الأطراف المتنازعة التي تراهن على تغذيتها، في الدولة والمجتمع، أمام مسؤولياتها، فليست استعادة الثقة في المجتمع عملية عاطفية أو أخلاقية فقط، وإنما فعل سياسي تأسيسي: إنها الشرط الأول لبناء مجتمع سياسي يعزز الأمل في الإنسان وفي قدرته على التعاون لتحقيق الخير المشترك، وبالتالي شرط لبناء المواطنة الحديثة، فلم يكن انهيار الثقة في سورية إلا الوجه الآخر لإعدام السياسة. فحين تُختزل السلطة في القوة، ويُختزل المجتمع في الهويات الأهلية الموروثة، ويتحوّل الأفراد إلى موالي وأزلام، لا يبقى معنى للثقة. ولن تمكن استعادتها إلا إذا أعيد للناس حقهم في الفعل وفي القول، وفي العدالة. فالثقة، كما ذكرت، ليست معطى ثقافيّاً جاهزاً، بل نتاج تجربة جماعية في العيش المشترك والتفاعل البناء والإيجابي بين الأفراد. حين يشعر السوري أن كلمته تُسمع، وأن حياته تُحترم، وأن القانون وجد ليحمي حقوقه لا لتطويعه والسيطرة عليه، عندها فقط تستعيد القيم معانيها وينحسر اليأس والقنوط، وتبدأ الثقة في الظهور من جديد. وينبغي للوصول إلى ذلك:
أولا، الاعتراف للضحايا بما وقع عليهم من ظلم وحقهم في التعويض المعنوي عنه، وتعويضهم بالفعل. تجاهل هذا الواجب وكأن شيئاً لم يكن لا يبقي الضغائن حية فحسب ولكنه يمنع المجرمين أيضاً من التعرف إلى جرائمهم، ويدفعهم إلى الاستمرار في الاعتقاد بأن ما قاموا به كان موقفا صحيحا، ويسمح لهم بأن يحوّلوا أنفسهم هم من جديد ضحايا ومظلومين ويتحوّلوا إلى فلول مرتدة على الوضع الجديد.
بناء الثقة يمر عبر بناء سردية وطنية جديدة تعترف بالآلام المتعددة، وتبحث عن معنى مشترك لما حدث، تحل محل السرديات المتعارضة التي ولدتها الحرب
كان على السلطة الجديدة أن تبدأ بهذه المهمّة، وتعلن أسبوعا للحداد على ضحايا الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وأن تتيح الفرصة لهم أن يفرغوا جعبة ذاكرتهم من الرضوض العميقة التي أصابتها، ويسردوا حكايتهم، ويشعروا بأن الشعب كله، وليس المذنبون وحدهم، يعترف بتضحياتهم، وأن تعطى لهذه التضحيات معانيها النبيلة التي تستحقها. هذا الاعتراف لا يمكن المرور عنه، ولا يمكن تجاوزه، فهو أثمن ما في العدالة وشرط إنهاء الحداد وإغلاق الجزء الأبرز، النفسي والمعنوي، من ملف الإبادة الجماعية.
ثانيا، تحقيق العدالة والمساءلة حسب القانون، والتمييز بين المحاسبة على الجرائم والقبض على المسؤولين الرئيسيين عنها ومحاكمتهم ومعالجة المظلوميات الجماعية التاريخية أو الحديثة. أما العفو من دون اعتراف ولا تعويض معنوي للضحايا فهو يزيد من الاحتقان ولا يخفف منه.
لا تتحقّق العدالة بتعميم الجريمة على الجماعات والطوائف بوصفها كذلك، فالحقوق المدنية فردية، وتعميمها على الطوائف تحت مسمى المظلومية لا يساعد على حلها، وإنما يزيد من استعارها بمقدار ما يحولها إلى اداة ابتزاز جماعي يقطع الطريق على العدالة الحقيقية.
هناك تمييز طائفي بالتأكيد، وينبغي إدانته وإيجاد الحلول له، لكنه مسألة مستقلة قائمة بذاتها، وينبغي معالجتها على المستوى السياسي والثقافي ورجال الدين، لا خلطها مع مسألة الجريمة بالمعنى الدقيق للكلمة، فلا توجد في القانون عقوبات محدودة أو تعويضات على المظلومية، إنما مرتكبو جرائم وضحايا من كل الطوائف، كما يوجد أبرياء منهم أيضا. والتعميم في المظالم يقضي على العدالة، لأنه يجمع بين المجرمين والأبرياء في الحكم ويعمم الاتهام على أفراد لم يكن لهم أي دور في الجريمة وهذا بحد ذاته جريمة. وربما يسمح للمجرمين بالهرب من المحاسبة باسم مظلومية طوائفهم.
ثالثاً، إعادة بناء المجال العام. فالثقة تنمو فقط في الفضاءات المشتركة: الجمعيات، النقابات، المنصات المدنية، البلديات، المنتديات الثقافية. كلما زادت ممارسة الفعل المشترك خارج الانقسامات الأهلية الضيقة تعززت ثقة الأفراد والجماعات بعضها ببعض وبنفسها. وكل مبادرة جماعية ناجحة، مهما بدت صغيرة، تعيد ترميم خيط من خيوط الثقة المقطوعة.
رابعاً، مساعدة الأفراد وتشجيعهم على تجاوز منطق الهويات المغلقة إلى منطق المواطنة الجامعة. وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بمقدار ما تكون هذه المواطنة حاملة لحقوق وحريات وآفاق ومستقبل أكثر غنى وتنوعا ومعنى. وهذا يتطلب خطاباً وطنياً جامعاً، وتربية مدنية جديدة، وإعادة تعريف “نحن” بوصفها مجتمعاً سياسيّاً مفتوحاً لا مكوّنات تخاف بعضها من بعض وتتنازع على اقتسام جلد الدولة (الغنيمة)، فالثقة لا تُبنى بين الهويات المغلقة، بل بين مواطنين متساوين في الحقوق والمسؤوليات.
خامسا، دعم الاقتصاد المحلي والتعاوني. فالثقة لا تنمو بالشعارات، وإنما من خلال اشتراك الناس في العمل والإنتاج، والإبداع. وتشكل المشروعات التعاونية، والمبادرات الاقتصادية المجتمعية، مختبرات لتوليد الثقة العملية، وتأكيد أن مصالح الأفراد مترابطة.
انعدام الثقة ليس كارثة طبيعية، وإن استعادتها لا تحتاج معجزة، وإنما إرادة طيبة تضع الأطراف المتنازعة التي تراهن على تغذيتها، في الدولة والمجتمع، أمام مسؤولياتها
سادساً، بناء الثقة يمرّ عبر بناء سردية وطنية جديدة تعترف بالآلام المتعددة، وتبحث عن معنى مشترك لما حدث، تحل محل السرديات المتعارضة التي ولدتها الحرب، والتي يعيد فيها كل طرف تمحوره حول مظلوميته الخاصة والفريدة. لا يعني هذا إنكار خصوصية الروايات إنما شمولها بسردية واحدة تعددية وصادقة تسمح للناس بأن يروا بعضهم بعضاً بوصفهم بشراً، لا أعداء.
سابعاً، لا يمكن إعادة بناء الثقة بالخطابات والوعود أو بالمراسيم والقرارات الحكومية، وإنما بتطوير مبادرات اجتماعية جديدة ومتنوعة، وبروز قيادات محلية صادقة ونخب جديدة، شفافة وملهمة وصادقة، من المثقفين والفاعلين السياسيين والناشطين، قادرة على تمثيل القيم لا الدفاع عن مصالح خاصة، وعلى التضامن لا على إعلان الوصاية السياسية والأيديولوجية. وهذا يعني: من خلال مراكمة الأفعال الأخلاقية والسياسية اليومية التي تساعد على اكتشاف معنى الحقيقة والعدالة والحق والكرامة والمواطنة. وهذه في الدرجة الأولى مسؤولية الدولة بوصفها القيمة على كشف الحقيقة وإحقاق الحق وتأكيد معنى القانون، مثلما هي مسؤولية جميع المعنيين بترميم العلاقات الاجتماعية وتصفية الإرث الماضي الثقيل وتحرير الضمير المكبل بسلاسل الشك والريبة وموت الأمل والروح.
علينا أن ندرك أنه لا توجد فرصة لاستعادة معنى المواطنة من دون استعادة الثقة الاجتماعية. ومن دونها يصبح المجتمع مجرد حشد لأفراد متنافرين يعيشون على أرض واحدة وقلوبهم شتى.
باختصار، بناء الثقة من جديد مشروع سياسي طويل الأمد، يبدأ من استعادة معنى الحقيقة والمساءلة. فالاعتراف بالجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها شرط لا يمكن تجاوزه. ولا يمكن للمجتمع أن يستعيد ثقته إلا حين يرى أن الظلم يُسمّى، وأن المسؤولية تُحمَّل، وأن الكرامة الإنسانية ليست سلعة يفاوض عليها.
- العربي الجديد